
مع انطلاق ماراثون التعديلات الدستورية في مصر والتي اقرها البرلمان بأغلبية 531 نائباً، مقابل رفض 22 نائباً، وامتناع نائبة واحدة عن التصويت، بإجمالي حضور بلغ 554 نائباً، من مجموع أعضاء البرلمان البالغ 595 نائباً ، تدخل البلاد في منعطف خطير من الديكتاتورية والتسلط وحكم الفرد العسكري، بغض النظر عن نتيجة الاستفتاء المضونة مستقبلا، بفعل التزوير الذي لا حاجة للنظام إليه، رغم الرفض الشعبي المتزايد، وغير المعبر عنه بصناديق الاقتراع التي بين يدي العسكر وبلا رقابة من منظمات او فعاليات سياسية مستقلة أو معارضة، اذ ان المعارضين لا مكان لهم بمصر الا بالمعتقلات أو بالمنفى….
حيث يواجه رموز تيار 25_30 المناوئين للسيسي ونظامه بسلسلة من البلاغات القانونية التي تحاصرهم، وكن اخرهم النائب أحمد طنطاوي الذي عبر عن عدم قبوله لشخص السيسي، وهو ما قابله رئيس البرلمان الذي من المفترض أن يحترم حرية رأي نوابه ويحميهم من اي تعد، فقام بحذف كلام النائب من المضبطة، يوم الثلاثاء الماضي، ثم انطلقت البلاغات القانونية ضد النائب من قبل محامين محسوبين على النظام، بدعوى الاساءة لشخص السيسي…
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات ، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الأربعاء، موعد إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية في خارج مصر وفي داخلها وذلك بواقع 3 أيام متتالية. حيث حددت أيام الجمعة والسبت والأحد ، في 19 و20 و21 إبريل الجاري، موعدا لإجراء الاستفتاء في الخارج.
كما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات أيام السبت والأحد والاثنين ، في 20 و21 و22 إبريل الجاري، موعدا لإجراء الاستفتاء في داخل مصر.
كما أعلنت الهيئة أن المصريين الوافدين بالمحافظات يحق لهم التصويت في كافة اللجان بربوع مصر ، وسط مناشدات اعلامية وسياسية مكثفة لعموم الشعب للمشاركة في الاستفتاء…
وتشمل تعديلات الدستور بمصر، 13 مادة مُعدلة و9 مواد مُستحدثة، وبخلاف مدة بقاء السيسي، نصت الترقيعات اللا دستورية 10 بنود اخرى:
استحداث مادة تجيز لرئيس البلاد أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم وأن يقبل استقالاتهم، تعديل مادة تولي للجيش مهمة الحفاظ على مدنية الدولة ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، وحظر إنشاء أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
واستحداث مادة تحدد مهام رئيس مؤقت للبلاد حال وجود مانع يحول دون مباشرة الرئيس لسلطاته، إذ يحل نائب رئيس البلاد أو رئيس الوزراء عند عدم وجود نائب الرئيس، وحظرت مادة الرئيس المؤقت جواز قيامه بطلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الحكومة، أو الترشح لهذا المنصب، واستحداث مادة بتشكيل مجلس الشيوخ (لا يقل عن 180 عضوا)، على أن ينتخب ثلثاه بالاقتراع ويعين رئيس البلاد الثلث الباقي، وتعيين رئيس البلاد لرؤساء الهيئات القضائية والنائب العام من بين ترشيحات مجالسها، لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغهم سن التقاعد (70 عاما) ولمرة واحدة طوال مدة العمل.
والسماح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في حال القيام بجرائم اعتداء على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو مناطق عسكرية، وتعيين رئيس البلاد لوزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتخصيص نسبة 25% من المجالس النيابية (النواب والشيوخ) للمرأة.
وايضا رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير قابلين للمساءلة أمام مجلس الشيوخ (الغرفة البرلمانية الثانية) للبلاد…
قمع المعارضين
وفي مقابل ذلك، واجه نظام السيسي انتقادات واسعة من جماعات حقوق الإنسان جراء قمع الخصوم السياسيين.
فيما دشنت المعارضة حملة “باطل”، مطالبين بمشاركة المصريين في الاستفتاء على الدستور بقول “لا”، داعيين لذلك في حملتهم “عايزين نقول كلنا في صوت واحد “لا” للتعديلات الدستورية”.
إلا أن الجهات الأمنية قامت بحجب موقع الحملة لثماني مرات، وتلى ذلك حجب نحو 34 ألف نافذة أخرى، وأعلن 11 حزبا سياسيا، أغلبها يساري وليبرالي، وشخصيات عامة وبرلمانية، تشكيل تحالف للدفاع عن الدستور.
دعاية الخوف
بينما عم حملات الدعاية للاستفتاء على الدستور الخوف، حيث تضمنت خطابًا يستخدم التخويف من المستقبل، كعصا سحرية للإخضاع؛ تخويفٌ من الفوضى، ومن الإرهاب، والانفلات الأمني، ومن كل ما يمكن أن يخافه المواطن المصري.
واستخدام النظام عصا التخويف، بدلًا من الإشارة لـ”الإنجازات” واستخدامها كمحفز لتمرير ما يشاء!
ومن ذلك ما قاله رئيس البرلمان علي عبد العال، بعد اقرار التعديلات والموافقة عليها بمجلس النواب بقوله: “أعود لأؤكد أن البلاد مرت بفترة عصيبة كانت وليدة تحديات جسيمة، انتفض فيها الشعب ضد محاولات تغيير هويته، واليوم فإننا على ثقة تامة بوعي المواطنين الذي سيحدد مستقبل البلاد، ويقودها نحو الأفضل”.
وبحسب نظريات ادارة المجتمعات البشرية، فقد أدرك “المتسلطون” منذ أمد بعيد قوة الخوف، كوسيلة ناجعة في كثير من الأحيان، في السيطرة على الجموع، حتى وإن كان الخوف متخيلًا، أو لا صلة له بواقع يصنع تهديدًا.
وكتب الفيلسوف الأيرلندي في القرن الـ18، إدموند بيرك، إنه “لا يوجد شعور يسلب المرء فعليًا كل سلطاته في التفكير والتصرف كالخوف”.
وأدركت الطبقات الحاكمة لآلاف السنين قوة الاستثمار في الخوف عند رعاياها كوسيلة للتحكم الاجتماعي. ولاحظ هنري فرانكفورت، عالم المصريات الألماني، في كتابه “المغامرة الفكرية للإنسان القديم”، أنه في الفترة ما بين عامي 1800 و1600 قبل الميلاد، انتشر “ذهان الخوف” في مصر القديمة، وذلك بسبب الغزو الأجنبي.
في البداية كان هذا الذهان حقيقيًا بسبب التهديدات المحتملة في كل وقت، لكن حتى بعد جلاء الغزاة، سعت السلطة لأن يبقى الخوف بين السكان وإن بشكل مصطنع، مدركةً أن السيطرة أسهل على مجموعة من الخائفين.
مخاطر التعديلات
التلاعب بالدستور لتأبيد حكم السيسي
وفي النقاشات التي شهدها البرلمان، وخلال جلسات الحوار المجتمعي، الشكلي، بالبرلمان، قال علي عبد العال، رئيس مجلس النواب : “إن التعديلات الدستورية المقترحة لن تكون الأخيرة، وسيجري العمل على وضع دستور جديد كليا للبلاد خلال 10 سنوات”..
وهو ما يعني أن التعديلات ستكون خلال سنوات حكم السيسي ، ما يهدد بطرح سيناريو آخر كانت تعده الأجهزة الاستخبارية، قبل طرح التعديلات الأخيرة، والمتعلق بانشاء مجلس صيانة الدولة، وألذي سيظل على رئاسته السيسي ايضا، الذي من الممكن أيضا في اطار الدستور الجديد، أن يصبح رئيس الجمهورية بعد انتهاء ولاياته المتعددة عضوا بمجلس الشيوخ مدى الحياة، وذلك تجنيبا له من المسائلة القانونية على أفعاله…
وتمدد التعديلات الحالية، لبقاء السيسي في الحكم، بالمخالفة لنصوص حاكمة وقاطعة في الدستور، وأجرى البرلمان التعديلات ليمكن لـ”السيسي” البقاء عامين إضافيين لفترته الحالية انطلاقا من قاعدة غير منطبقة يرددونها “الأثر الفوري والمباشر”، ثم يحق له الترشح لست سنوات إضافية، ليكن موعد رحيله المفترض هو 2030، متنازلا عن أربع سنوات من الحكم، كانت تتيحها الصيغة السابقة للتعديلات.
وكان التعديل المطروح والمتوافق عليه، وفق ما نشر في الإعلام المصري، يتيح للسيسي الترشح لفترتين إضافيتين مدة كل منهما ست سنوات بالإضافة إلى الفترتين الحاليتين ومدة كل منهما أربع سنوات، ليبقى مع المصريين حتى عام 2034.
وبحسب مراقبين تهدف التعديلات إلى مزيد من شرعنة الانقلاب واستمرار اغتصاب إرادة المصريين ما يكرث سلسلة من المخاطر الاقليمية والمحلية، في ظل
رهن القرار المصري للأنظمة العالمية والارتماء في حضن الصهاينة، والتفريط في مياه النيل والغاز وأرض الوطن لغير المصريين.
اهدار استقلال القضاء
وبحسب مراقبين، جاءت التعديلات مكرسة لتحكّم السيسي “السلطة التنفيذية” الكامل بالقضاء المصري، ومهدرةً ما كان متبقياً من استقلاله.
وجاءت التعديلات البسيطة التي أدخلت في الأيام الأخيرة للإيحاء بالاستجابة لمخاوف القضاة وأعضاء الهيئات القضائية في ما يتعلق بمسألة إهدار استقلال موازناتهم، ووكالة وزير العدل عن السيسي في رئاسة المجلس الجديد لشؤون الهيئات القضائية، لكن التغييرات، أكدت، في الحقيقة، التبعية المطلقة للهيئات القضائية لرئيس الجمهورية.
وتضمنت التعديلات، عودة النصّ على “استقلال الموازنات الخاصة بالهيئات القضائية” إلى المادة 185، مع حذف عبارة أن تدرج كل موازنة في الموازنة العامة للدولة “رقماً واحداً”. ويعني هذا الأمر الاستقرار على حل وسط بين تبعية الموازنات لوزارة العدل واستقلال كل هيئة بموازنتها وعدم تمكن البرلمان والحكومة من مراقبتها. وستتم مراقبة جميع الموازنات بتفاصيلها الداخلية وتصرفات الهيئات المختلفة فيها، وبالتالي ينتهي عهد استقلال كل هيئة قضائية بموازنتها ونأيها عن الرقابة الداخلية. وتتحقق بذلك أهداف السيسي، والتي حاول تنفيذها منذ 4 سنوات، عندما أصدر سلسلة من القوانين والقرارات لإخضاع القضاة للحد الأقصى للأجور ولم يكن متمكناً من تنفيذها على نحو كامل بسبب استقلال الموازنات على النحو المقرر في دستور 2014.
ويضفي النص النهائي، حماية دستورية على القانون الذي أصدره السيسي في إبريل 2017، ويجعله صاحب القرار الأخير في تعيين رؤساء الهيئات القضائية من بين أقدم 7 قضاة، مما سيؤدي إلى انتفاء جدوى الطعون المرفوعة حاليا أمام المحكمة الدستورية العليا على قانون تعيين رؤساء الهيئات، باعتبار أن النصوص المشكوك في دستوريتها ستغدو دستوراً بحد ذاتها، وينتفي أساس الطعن فيها.
كما تضمنت التعديلات استجابة جزئية لموضوع آخر ركز عليه القضاة الذين تم اختيارهم لحضور جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، ويتعلق بترؤس وزير العدل للمجلس الأعلى للهيئات القضائية الجديد في حال غياب رئيس الجمهورية. وينص التعديل النهائي للمادة 185 على أن يفوض رئيس الجمهورية أحد رؤساء الهيئات (وليس رئيس المحكمة الدستورية العليا بالذات كما كان يطالب القضاة) لرئاسة هذا المجلس الأعلى في غيابه، وبالتالي تم استبعاد وزير العدل تماماً من عضوية المجلس.
لكن في مقابل هذه الاستجابة الجزئية، والتي لا تعني الكثير على أرض الواقع، تضمنت المادة عدداً من البنود التي تؤكد تحكّم رئيس الجمهورية بالمجلس، في شكل كامل. وأصبح المجلس يضم كلاً من رئيس المحكمة الدستورية ورئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة ورئيس النيابة الإدارية ورئيس هيئة قضايا الدولة، بالإضافة إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام؛ وهؤلاء جميعاً في الوقت الحالي معينون باختيار شخصي من السيسي، عدا رئيس المحكمة الدستورية حنفي جبالي الموالي للسيسي لكنه تولى منصبه بالأقدمية، ورئيس محكمة استئناف القاهرة الذي يتولى منصبه بالأقدمية المطلقة أيضاً.
وبالتالي، فإنه من خلال تحكّم السيسي المطلق بتعيينات رؤساء الهيئات القضائية، بما في ذلك المحكمة الدستورية العليا بعد التعديل الحالي، سيكون هو الذي يختار بشكل مسبق أعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية، الذين ستوكل إليهم ـ وفق النص الدستوري الجديد- مناقشة الشؤون المشتركة للهيئات وأعضائها والتعيينات فيها وإبداء الرأي في تعديلات القوانين المنظمة لها.
لكن النص يتضمن ما هو أبعد من ذلك، حتى لا يترك أي فرصة لتمرير قرار أو موقف ضد إرادة السيسي، فعند أخذ التصويت على قرارات المجلس الأعلى، ولدى تساوي عدد الأصوات، سيتم ترجيح كفة رئيس الجمهورية أو من يفوضه لرئاسة المجلس الأعلى. علماً بأن المجلس الأعلى سيكون له أمين عام، سيعينه أيضاً رئيس الجمهورية لمدة يحددها القانون الذي من المنتظر أن يكون على رأس أعمال الدورة البرلمانية المقبلة.
أما في ما يتعلق بالنصوص الخاصة بالهيئات القضائية، فلم يتم أي تعديل على النص المقترح للمحكمة الدستورية التي سيتم إهدار استقلالها بالكامل، إذ سيختار رئيس الجمهورية رئيسها المقبل ومن يليه من بين أقدم 5 نواب لرئيس المحكمة، ويعين عضو المحكمة الجديد من بين اثنين تُرشِّح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويُرشِّح الآخر رئيس المحكمة، ويعين رئيس هيئة مفوضي المحكمة وأعضاءها بناء على مقترح من رئيس المحكمة بعد أخذ رأي جمعيتها العامة.
ورجحت مصادر قضائية عدم معارضة قضاة المحكمة الدستورية لهذا النص، والذي يمثل تراجعاً كبيراً عن الدور والاستقلال اللذين نالتهما المحكمة في السنوات الأخيرة، نظراً لأن النص المقترح بأن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم 5 أعضاء منها، فتح باب الأمل لبعض هؤلاء القضاة لرئاسة المحكمة لفترة طويلة تناهز 10 سنوات، ما يغلب المصلحة الشخصية لبعضهم– في حال اختيارهم- على المصلحة العليا للمحكمة باستمرار اتباع مبدأ الأقدمية المطلقة في اختيار رئيسها، وهو المبدأ الذي كانت المحكمة قد طالبت بتنفيذه طويلاً حتى تم تضمينه في دستور 2012 لأول مرة.
أما المادة 189 الخاصة بالنائب العام فبقيت كما جاءت في النسخة الأولى من التعديلات، إذ يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيينه بعدما يختاره من ثلاثة قضاة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، الأمر الذي كان يتم من قبل بصورة عرفية، لكن النص الدستوري الجديد سيكسبه صفة دائمة وقاعدية، حتى تظل الرئاسة متحكّمة بهذا المنصب الحيوي المهم.
وفي ما يتعلق بالمادة 190 الخاصة بمجلس الدولة، فقد أدخلت على التعديل المقترح تغييرات بسيطة تمثلت في استمرار المجلس في مهمته بمراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية في العموم، لكن مع حذف سلطة المجلس في “صياغتها” والتي كان منصوصاً عليها في دستور 2014، كما تم تقليص سلطة المجلس في مراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، بحيث يلزم النص الجديد بإصدار قانون يحدد قيمة العقود التي يراجعها مجلس الدولة، وبالتالي لم تعد مراجعة العقود من اختصاصه بشكل عام، فضلاً عن إلغاء السلطة الحصرية للمجلس في الإفتاء في المسائل القانونية.
وأوضحت مصادر قضائية بمجلس الدولة أن قضاة المجلس ليسوا راضين عن هذه التعديلات، ويعتبرون التغيير الذي طرأ على المقترح الأول للتعديلات “لعبة سياسية قامت على تخفيض سقف طموحات القضاة في التعديل ثم مساومتهم على استقلالهم السياسي مقابل حريتهم المالية غير الكاملة”. وأشارت المصادر إلى أن حملة الدعوة لمقاطعة الإشراف على التعديلات لا تزال قائمة رغم التهديدات التي تلقاها المروجون للمقاطعة، والضغوط التي مورست حتى على رئيس نادي المجلس المستشار سمير البهي وأدت إلى إصداره بياناً يزعم أن رأيه المعارض للتعديلات “شخصي وليس مؤسسياً”.
الجيش وحماية المدنية
كما منحت التعديلات الجيش سلطة صون الديمقراطية ومدنية الدولة، فضلا عن اشتراط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع.
واعتبر قضاة هذه التعديلات هو تغول من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، فضلا عن وضع الجيش فوق الدولة بصفته حاميا للدستور ومدنية الدولة.
وبحسب الخبير القانوني والمحامي الدولي ، محمود رفعت، فقد احتل الجيش مساحة فوق دستورية بل فوق الشعب كله، فإلى جوار الحفاظ على أمن البلاد أضيفت مهمة الحفاظ على مكتسبات الشعب ومدنية الدولة للقوات المسلحة التي سيصبح من دورها أيضا صون الدستور والديمقراطية.
وقد وصف موقع “ستراتفور” الأمريكي،
وهو مركز دراسات إستراتيجي وأمني أمريكي يعد أحد أهمّ المؤسسات الخاصة التي تعنى بقطاع الاستخبارات – أن “التعديلات” ستكون طوق نجاة من التفويض السياسي الذي نالته القوات المسلحة لمساحة أكبر للمجلس الأعلى للقوات المسلحة كي يصبح هو صاحب الكلمة الأخيرة في تعيين وزير الدفاع في الحكومة المدنية.
وكشف عن أن الأهم من ذلك أن صيغة التفويض المنوطة بجيش البلاد خضعت لتعديل دقيق، لكنه خطير، مع تعريف الجيش الآن بأنه “المؤسسة المكلفة بحماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد”.
وذكر الموقع أن خطورة التعديلات تكمن في كونها صمّمت بالأساس لتعزيز قدرة رئيس بعينه على توجيه سياسات مصر، والأكثر من ذلك، تكريس القوة السياسية للجيش على حساب الحكومة المدنية. وبناء على صيغة التعديل التي تحدد صلاحيات الجيش، يمكن للجيش أن يبرر أي إجراء يتخذه على أنه خطوة “لحماية” الدولة حتى لو لم توافق الحكومة المدنية.
ويبدو أن هذا التعديل للمادة 200 من الدستور يزيل بشكل نهائي إشراف الدولة المدنية على أعمال الجيش.
وأكد ستراتفور أن حكومة السيسي تعمل بالتنسيق الوثيق مع الجيش، الذي يتزعمه المجلس الأعلى للقوات المسلحة للسيطرة على مقاليد الحكم في صورة بطانة سياسية مدنية من خلال التعديلات ، وهو الذي تسبب في الانقلاب على الرئيس “محمد مرسي”، عام 2013.
التمهيد للتوريث
ومن ضمن المخاطر التي تثور واقعيا، عقب اقرار التعديلات بشكل نهائي؛ عودة سيناريو التوريث الذي أبطلته ثورة 36 يناير، حيث نشرت صحيفة “التايمز” تقريرا لمراسلها في منطقة الشرق الأوسط “ريتشارد سبنسر” بعنوان ” السيسي يجند أولاده لمساعدته على البقاء في السلطة حتى 2030″.
يقول “سبنسر” إن “أبناء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشاركون بقوة في إدارته للبلاد خلال الفترة التي يسعى فيها إلى تمرير تعديلات دستورية تشدد قبضته على السلطة حتى العام 2030”.
مضيفا أن السيسي بحلول العام 2030 سيبلغ من العمر 76 عاما.
يشار إلى أن ابن السيسي محمود، الجنرال في المخابرات المصرية هو من يدير لجنة غير رسمية تراقب تطورات الإصلاحات المقترحة. أما ابنه الأكبر، مصطفى وهو مسؤول بارز في سلطة الرقابة الإدارية والتي أصبح لها دور مهم في ظل السيسي وهو يحاول تأكيد سلطة الجيش على البيروقراطية.
وهناك ولد ثالث اسمه حسن، وعمل مديرا في شركة نفط قبل أن ينضم للمخابرات.
وقد برز دور نجل السيسي، محمود، الذي يعمل بالمخابرات العامة، في ادخال تعديلات اللحظة الأخيرة على التعديلات الدستةرية،
والتي بموجبها يتم تمديد الفترة الحالية حتى 2024، مع السماح بترشح السيسي لولاية تالية تنتهي في عام 2030. وقالت المصادر، في حديث مع “العربي الجديد”، إن نجل السيسي محمود (ضابط في الاستخبارات العامة)، ومستشار الرئيس القانوني محمد بهاء أبو شقة، مررا اقتراح التعديل إلى رئيس البرلمان، ومقرر لجنة الصياغة محمود فوزي، بهدف تأجيل انتخابات الرئاسة التي كانت مقررة بعد ثلاث سنوات لمدة عامين إضافيين، على ضوء التقارير التي تصل إلى مؤسسة الرئاسة بشأن حالة الاحتقان في الشارع، من جراء تردي الأوضاع المعيشية، وتصاعد حدة موجة الغلاء.
وأوضحت المصادر أنّ تأجيل الانتخابات يستهدف إعطاء مهلة أكبر للرئيس الحالي لتحقيق حالة من الاستقرار السياسي والاقتصادي، خصوصاً أنّ الحكومة تعتزم إلغاء الدعم نهائياً عن الوقود والكهرباء والغاز والسلع التموينية خلال العامين المقبلين، ما قد يترك أثراً سلبياً على مؤشرات التصويت، في حال إجراء التصويت في عام 2022، ويعطي أملاً لمنافسين محتملين لخوض الانتخابات في مواجهة السيسي، نظراً لتراجع شعبيته.
فيما تابعت المصادر أنّ السبب الأهم وراء التأجيل يعود إلى أن قانون هيئة الانتخابات، ينصّ على إلغاء الإشراف القضائي الكامل على جميع الاستحقاقات الانتخابية بحلول عام 2024، وهو ما يعني إجراء الاقتراع في الاستحقاق الرئاسي تحت إشراف الأجهزة المحلية، وتولي وزارة الداخلية مسؤولية تأمين صناديق الاقتراع، ما يسهل من عملية تزوير الأصوات في غياب إشراف القضاة، في ردة تعيد مصر إلى عهود ما قبل ثورة 25 يناير 2011.
وصادق السيسي على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، في أغسطس 2017، بعد أن أقرّه مجلس النواب بالصيغة نفسها التي وردت من الحكومة، لينصّ على “إلغاء الإشراف القضائي الكامل على الاستفتاءات والانتخابات في 17 يناير 2024″، إذ رفض رئيس البرلمان حينها الطلب المقدّم من 31 نائباً، بشأن الإبقاء على الإشراف القضائي من دون التقيد بمدة زمنية، كزيادة في الضمانات الخاصة بنزاهة الاستحقاقات.
وأفادت المصادر بأنّ سيناريو تعديل مادة الرئاسة جرى إعداده على عجل، بالتزامن مع زيارة السيسي الأخيرة إلى واشنطن، وتلقيه – في ما يبدو – توبيخاً من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن مقترح تعديل الدستور الذي يقضي باستمراره في الحكم حتى 2034. وأشارت إلى أنّ نجل السيسي محمود وأبو شقة، شددا على عدم إدلاء هيئة مكتب اللجنة التشريعية بأي تصريحات إعلامية حول مدى دستورية المقترح، وترك تلك المهمة لرئيس البرلمان.
كما بينت المصادر أنّ رئيس مجلس النواب علي عبد العال عمد إلى الحديث عن أهمية وضع دستور جديد لمصر، خلال مدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات، لإيصال رسالة مفادها بأنه يمكن إدخال تغييرات أخرى قبل انتهاء ولاية السيسي بموجب التعديلات الدستورية الجديدة، خصوصاً أنّ لجنة الصياغة رفضت مقترحاً بشأن حظر ترشح الرئيس الحالي مجدداً، وذلك في المادة الانتقالية التي استحدثت على قياسه..
اهدار حقوق الانسان
ومن ضمن المخاطر التي تنطوي عليها التعديلات الدستورية، اهدار حقوق الانسان بمصر، حيث وصفت منظمة العفو الدولية موافقة البرلمان على التعديلات، بأنها تدل على ازدراء الحكومة لحقوق الإنسان، وأن قرار طرح هذه التعديلات في استفتاء عام، وسط أسوأ حملة قمع على حرية التعبير، وفرض قيود شديدة على الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام المستقلة، إنما يدل على ازدراء الحكومة لحقوق الجميع في مصر”.
وقالت: “بدلاً من التقيد بالتزامات مصر بحقوق الإنسان، اختار البرلمانيون الموافقة على التعديلات التي من شأنها تسهيل حملة القمع التي تشنها السلطات على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، وحرية التجمع، وتقويض حقوق الشعب، ومفاقمة أزمة حقوق الإنسان في البلاد”.
وأضافت “العفو” : “تهدف هذه التعديلات إلى توسيع نطاق المحاكمات العسكرية للمدنيين، وتقويض استقلال القضاء، وترسيخ الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها أفراد قوات الأمن، مما يفاقم مناخ القمع الموجود أصلاً في البلاد”
ولعل القادم هو الأسوأ في ظل حكم السيسي وتمرير التعديلات المؤبدة لحكمه، ولجوء نظام السيسي لأساليب العصابات في ادارة شئون البلاد، وهو ما تجلى في التلاعب بالشعب في تمرير التعديلات الدستورية، فمن حصار الميادين إلى حجب المواقع الإلكترونية، وصولاً إلى التضييق والاعتقال، تستمر السلطوية في مصر، في ذلك كله، حتى في استحقاق الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي أوجدته السلطة، ليعلن الشعب نظرياً، قبوله أو رفضه، فيما عمليا يمثل تمرير التعديلات مشهدا للإذعان، ليس فيه ملامح لحرية التعبير أو الاختيار. وهو أيضا تجسيد لفرض سلطة الأمر الواقع، بغرض استدامة عملية هيمنة مطلقة، عنوانها الرئيسي حكم الفرد، حتى وإن تجمل بعضهم بأن التعديلات تضمن بقاء الدولة والحفاظ على استقرارها وقوتها، واستكمال خطط التنمية، وغيرها من مصطلحات تصاحب عمل كل نظام على البقاء في الحكم.
يبرز الواقع أن المصالح الاقتصادية تلعب دورا رئيسيا في تمرير التعديلات الدستورية، هي انعكاس لسيطرة فئات وطبقات اجتماعية على الحكم والاقتصاد والثروات، مستخدمةً كل أدوات القمع والتخويف، بجانب تزييف الوعي، لتبقى على مكاسبها المرتبطة باستمرار النظام، ولذلك تسانده بقوة.
فبحسب المحلل السياسي عصام شعبان بـ”العربي الجديد”: “لا يمرر المشهد بالتضييق والدعاية وحسب، فهناك رشاوى، بعضها اقتصادي في شكل منح وعلاوات وترقيات، جاءت لتحاول معالجة الشروخ في الكتلة الاجتماعية التي كان جزء منها يؤيد سياسات النظام، لتستفيق على الأزمة الاجتماعية المتسعة يوما بعد يوم. وهنا تظهر العلاقات الاقتصادية بين الدولة وموظفيها بوصفها إحدى أدوات الإخضاع والهيمنة والاستمالة والاستقطاب، لأن العقوبات الإدارية غير كافية في إخضاع الموظفين وحشدهم في التصويت. ولذلك استخدمت الدولة بند الأجور حوافز تسهل عمليات الهيمنة السياسية وكسب التأييد والولاء.
وهناك أيضا مصالح سياسية متنوعة، فالتعديلات تتضمن بندا بإنشاء غرفة برلمانية ثانية، ستستوعب بعض النخب التي يلحظ تململها من التهميش الذي فرضته السلطة عليها، على الرغم من ولائه لها، بجانب وعودٍ بمنح النساء والشباب والأقباط نِسبا في البرلمان المقبل، وهو ما ينعكس في دعاية حملات طرق الأبواب والأنشطة الدعائية التي تمارسها منظمات نسوية تابعة للدولة، أو مجموعات شبابية كتنسيقية شباب الأحزاب، وكذلك توجهاتٌ كنسية تستغل حالات التميز الديني والحوادث الطائفية ومشكلات الأقباط في حشدهم للتأييد، مصورين أن أي معارضةٍ للنظام هي اصطفاف مع تيار الإسلام السياسي، والإخوان المسلمين تحديدا، وما يحمله هؤلاء من أفكار تهدّد أوضاع الأقباط وتزيدها تعقيدا.
يتضح أن عملية تعديل الدستور، بداية من طرحها وترويجها وحتى إقرارها ، تتسم بالقسرية، فالإعلان ليس تعبيراً عن إرادة شعبية، ولكن يراد أن يصوّر بهذه الصورة عند إقراره من خلال الاستفتاء، فأعضاء مجلس النواب الذين مرّروا التعديلات يريدون تحقيق فوز سهل مستقبلا في الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر اختيارهم ضمن قوائم السلطة التي لا بد أن تستمر، لكي يضمنوا وجودهم في البرلمان المقبل، ويحققوا مصالحهم ومصالح من موّل حملاتهم أو من أوصى بمرورهم السهل إلى البرلمان، حتى الذين تغيبوا عن جلسة التصويت على مقترح التعديلات الدستورية في الجلسة العامة للبرلمان، حرصوا على إصدار بيانٍ لاحقا لتأييد مقترحات التعديلات الدستورية، حتى لا يغضب منهم من جاءوا بهم إلى البرلمان.
لم يعكر صفو هذا المشهد السلطوى الذي يشبه اللعب المنفرد سوى ما سمّي حوارا مجتمعيا، شاركت فيه شخصيات عامة وأحزاب فى جلسات استماع في مجلس النواب، لكن هذا الحوار لم تعلن تفاصيله في أي وسيلة إعلامية مصرية، وكأنه كان همسا مشينا. ولكن سرعان ما تكشف أن “مشهد الحوار” بشأن التعديلات الدستورية كان ضمن ثلاث قضايا رئيسية طرحت في زيارة رسمية لعبدالفتاح السيسي إلى واشنطن، بجانب قانون الجمعيات الأهلية الذي تم تغيره قبل الزيارة بيومين، ومسألة تسهيل عمل الأجانب في الجمعيات الأهلية والحقوقية،
وتحفيز أنشطة المستثمرين الأجانب في السوق المصري.
وإلى ذلك، يستمر مشهد التأييد الكاسح، والعزف الفردي، والنغمة الواحدة التي لم تشأ السلطة كسرها ولو شكليا، فطلب التظاهر الذي قدمته أحزاب الحركة المدنية لإعلان موقفها رفضته الحكومة، كما تم التضييق على التحرّكات المحدودة للمعارضين، وصلت إلى حدود إعاقتها بأساليب عفا عليها الزمن، كتعطيل مصاعد أحد العقارات التي كانت ستقيم بها الحركة ندوة محدودة الحضور. بينما شهدت شوارع القاهرة وميادينها الرئيسية، صباحي يومين متتاليين، غابات من لافتات تأييد للتعديلات الدستورية، أرغم فيها أغلب أصحاب المنشآت التجارية على دفع تكاليفها وإعلان تأييدهم قسريا، في مشهدٍ يحاول الإيحاء بأن هناك تأييدا شعبيا للتعديلات الدستورية، أو المستهدف منها، وهو تمديد فترات الحكم، وكذلك الإيحاء لهؤلاء أن سلامتهم واستمرار أنشطتهم مرتبط بتأييد السلطة، وأنه لا مكان في السوق/ الشارع لمن يتبنى غير هذا الموقف.
ومن فضاء السوق إلى الفضاء العام، تم إجهاض بداية تشكل حركة معارضة التعديلات الدستورية، عبر القبض على شباب ممن حاولوا تشكيل حراكٍ معارضٍ للتعديلات، خصوصاً من أعضاء حزب الدستور، ومن تضييق فضاء الشوارع الذي تم تأميمه لصالح لافتات التأييد وحركاته، ومنعت فيها الأصوات المعارضة، وصلت السلطة إلى عرقلة الفضاء الإلكتروني الذي يعبر فيه المصريون، بشكل نسبي، عن معارضتهم النظام، حظرت الدولة الموقع الإلكتروني لحملة “باطل”، والذي أطلق للتوقيع على وثيقةٍ ترفض تعديل الدستور. لم يستمر الموقع سوى 13 ساعة، وصلت فيها التوقعات إلى نحو 60 ألف توقيع، ما يدل على أن هناك أصواتا تريد التعبير عن رفضها التعديلات الدستورية، وما تمثله من استمرار نمط الحكم القائم الذي يتناقض مع أبسط المطالب التي رفعها المصريون عشرات السنين بشأن التداول السلمي للسلطة، ووجود دستور يضمن الحقوق والحريات العامة.
وبحسب مراقبين، فإن مشهد تعديلات الدستور صورة أكثر وضوحا عن سمات النظام في مصر وخصائصه، بما فيها من أدوات للإخضاع والهيمنة والاستمالة والحصار، وهو أيضا صورة على حالة قوى المعارضة، ورغبة المصريين في التعبير المحتجز حتى فى الفضاء الإلكتروني.
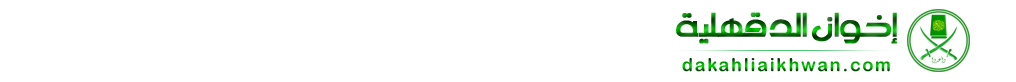 إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية



