
بعد دقائق من إعلان وفاة رئيس تونس المنتخب، الباجي قائد السبسي، تمت عملية انتقال سلس للسلطة، إلى رئيس مجلس الشعب، بشكل هادئ ومن دون ضجيج أو صخب، وربما قبل أن يصل خبر رحيل السبسي إلى كثيرين في تونس وخارجها.
أما في مصر، وفي مناسبة أربعين يومًا على استشهاد رئيسها المنتخب في أثناء محاكمة ظالمة وعبثية، فقد كان الوضع مختلفًا تمامًا، إذ أخرج الساحر من جرابه فضيحة سياسية وأخلاقية من الحجم الكبير، بطلاها ابن رئيس مصر المخلوع بفعل ثورة يناير، ورئيس تحرير صحيفة يومية، استخدمت فيها أقذر الأسلحة، وأعنفها.
في هذا الطقس الصاخب، مر خبر شراء حكومة السيسي صمت الحكومة الإيطالية على جريمة مقتل الباحث الإيطالي، جوليو ريجيني، في القاهرة، لقاء نحو سبعين مليون يورو وضعتها القاهرة في خزينة روما، بمضاعفة مشترياتها من أسلحة القمع البوليسي.
وعلى هدير المعركة، ما عاد أحد يهتم بأن رئيسًا منتخبًا تمت تصفيته ثم دفنه، من دون أن يسمح لأحد بالعزاء فيه، وأن 300 يومًا مرت على اختطاف السلطات النائب السابق، مصطفى النجار، وإخفائه قسريًا، وأن هناك نحو 60 ألف ضحية محتملة داخل الزنازين تنتظر مصيرًا مجهولًا.
الفرق بين ما جرى في تونس وما يجري في مصر هو الفرق بين النظام السياسي واللا نظام الفاشي، أو هو الفرق بين دولة المؤسسات وشبه دولة التشكيلات العصابية والتنظيم المسلح.. هو باختصار الفرق بين مجتمع إنساني وسياسي ومستنقع للهمجية.
والوضع كذلك، من الطبيعي أن تمضي تونس في إجراءات الدعوة إلى انتخابات رئاسية، بينما تغرق القاهرة في وحل البذاءة والشماتة في الأموات والأحياء، بل ويتم تصدير كمياتٍ من بذاءة المشاعر والكلمات خارج الحدود، فينصّب بعض الناس أنفسهم أوصياء على مشاعر بعضهم الآخر، فيما يقطع آخرون شوطًا أبعد، ويمنحون أنفسهم اختصاصات إلهية، بمصادرة الترحمات على هذا، وإطلاقها بسخاء على ذاك، من الرئيس الشهيد محمد مرسي إلى الرئيس التونسي الباجي السبسي، مرورًا بالفنان فاروق الفيشاوي.
غير أن الأكثر فداحة هو التفاعل الواسع مع المعركة البذيئة المشتعلة على مواقع التواصل الاجتماعي بين ابن حسني مبارك وتلك الصحيفة السيسية، والتي اخترقت حاجز الأخلاق والأعراف والتقاليد، والقوانين أيضًا، لتصل إلى مرحلةٍ من فحش تصنيع الوثائق المشينة وترويجها. والأفدح من ذلك كله أن يهبط فريقٌ محسوب على الثورة ومقاومة الانقلاب إلى هذا المستنقع العفن، ويستخرج جيفًا ليقيم عليها حفلات شواء، ويدعو الجمهور إلى تناولها، وهو يحسب أنه يحسن صنعًا، ويدعم قضية الثورة والمعارضة، استثمارًا في فضائح الخصوم، المصنوعة بدهاء، والمطروحة في الأسواق للاستهلاك.
لم يتوقف أحد عند فرضية أن ما يتعاطى معه باعتباره وثيقة إدانة للخصم، قد يكون فخًا منصوبًا بمهارة للتوريط في فضيحة مهنية لا تقل كارثيةً عن فضائح حرب الوثائق مجهولة المصدر، الآتية من حضيض الانحطاط الإنساني، والتي لا يمكن لصاحب عقل أو ضمير أن يستقبلها باعتبارها حقيقية.. كما لم ينتبه أحد إلى أن السباحة في المستنقعات ليست عملًا ثوريًا، أو معركة تخص الثورة أو تفيد المعارضة.
شيٌ من ذلك حدث، وتكرّر كثيرًا، ومنذ اختطف عبدالفتاح السيسي السلطة، كلما كانت منظومة الانقلاب تواجه مأزقاً سياسياً، تنفجر بالوعات الفضائح الأخلاقية فوراً، من خلال اختراع حكاياتٍ ساقطة في قاع الإسفاف عن “عنتيل” هنا، وآخر هناك، يتم فرضها موضوعاً رئيساً على وسائل الإعلام والاتصال، في إطار ما أسميته، في ذلك الوقت، عملية إذابة الوعي الجمعي في غاز سيانيد الفضائح الأخلاقية، والحواديت الأمنية الركيكة، والمعاركة الفارغة من أي مضمون أخلاقي أو سياسي.
مرة أخرى: نقاء الغاية يستدعي نظافة الوسيلة، ولا يمكن لقضيةٍ محترمة أن تنتصر بأسلحة غير نظيفة، حتى لو كان الخصوم موغلين في استخدام أحط الوسائل، وأقذر الأسلحة وأفتكها.
لا توجد ثورة تنتظر ما يتساقط من لحوم خصومها وهم يفترسون بعضهم بعضًا لتتغذّى عليه، فالثورات لا تأكل الموقوذة والمتردّية والنطيحة.
نقلا عن “العربي الجديد”
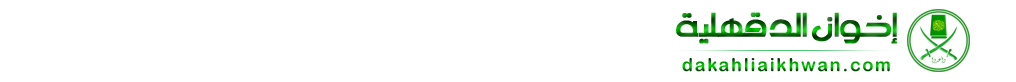 إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية



