
يظن بعض الناس أن السلامة والسعادة فى قول «نعم» وتجنب مواجهة الطغاة، ويرون الشجاعة والإقدام يجلبان المشكلات والهموم ويجعلان صاحبهما مضطهدًا منبوذًا، ولا يدرك هؤلاء -كما يقول ابن القيم فى زاد الميعاد-: «أن الشجاعة من أسباب السعادة، فإن الله يشرح صدر الشجاع بشجاعته وإقدامه؛ لأن الهمّ والقلة والذلة وحقارة الحال، تأتى من الجبن والهلع والفزع، وأن السعادة والانشراح والضحك والبسطة تأتى مع الشجاعة والإقدام وفرض الرأى وقول كلمة الحق التى علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه»..
فالرجولة تحمل صاحبها على معالى الأمور، وتجعله قويًا فى نفسه، مدافعًا عن الحق، متربصًا كالأسد لذئاب البشر الغاصبين لحقوق وحريات الآخرين.. يقول الدكتور القرضاوى فى كتابه «من أجل صحوة راشدة»: «ولن تترعرع الرجولة الفارعة، ويتربى الرجال الصالحون، إلا فى ظلال العقائد الراسخة، والفضائل الثابتة، والمعايير الأصيلة، والتقاليد المرعية، والحقوق المكفولة، أما فى ظلام الشك المحطم، والإلحاد الكافر، والانحلال السافر، والحرمان القاتل، فلن توجد رجولة صحيحة، كما لا ينمو الغرس إذا حُرم الماء والهواء والضياء».
إن من اعتادوا حياة الذل، والسير كالقطيع فى ركبان الفاسدين، يصعب عليهم مجرد الاعتراض على ما يقولونه ويفعلونه.. ولو فكروا ذات مرة فى معارضتهم فإنهم يرتجفون وتنتابهم رعشة جسدية وزلزال داخلى، فيتراجعون صاغرين، راضين بحياة العبودية والرق على حياة العزة والكرامة، ومَنْ يرض بالاستكانة فسوف يرض بالإهانة، ومن لا يستطيع قول «لا» فسوف يرعى مع الخراف، يساق إلى حيث يريد سائقه.
وإن مما يقدح فى عزة المسلم أن يقدم التنازلات لخصوم الإسلام وأعداء الدعوة، تبدأ هذه التنازلات قليلة صغيرة، وتنتهى بالانحراف الكامل فى نهاية الطريق.. وخصوم الإسلام يدركون تمامًا أن الذى يقبل المساومة فى دعوته ولو بشكل يسير فى المرة الأولى، سوف يقبل بالتفريط فيما هو أكبر بعد ذلك، وهم يستخدمون مع هذا الصنف من الناس طريقة (العصر)، فكلما وجدوا منه استجابة ضغطوا عليه من أجل المزيد؛ كالليمونة لا تكف اليد عن عصرها حتى ينفد ماؤها ولا يبقى منها سوى (القشرة)، التى يكون مآلها سلة المهملات!!
كان المسلمون بعد موت النبى -صلى الله عليه وسلم- كالغنم فى الليلة المطيرة، كما وصفتهم السيدة عائشة -رضى الله عنها- حتى قال بعض المسلميـن لأبى بكر: «يا خليفة رسول الله.. لا طاقة لك بحرب العرب جميعًا، الزم بيتك، وأغلق بابك، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، لكنه -رضى الله عنه- صاح فى وجه عمر: «أجبار فى الجاهلية خوار فى الإسلام؟! لقد تم الوحى واكتمل.. أفينقص الدينُ وأنا حي؟! والله لو منعونى عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- لقاتلتهم عليه، والله لأقاتلنهم ما استمسك السيف بيدي». فما كان من عمر -رضى الله عنه- إلا أن قال: «لقد شرح الله صدر أبى بكر للقتال، فعلمتُ أنه الحق».
إن المؤمن المستعلى بإيمانه، لا يغير جلده، ولا يتدنى بالاستجابة لمبغضه وعدوه، وهو يقبل العذاب ولا يقبل إقرار الظالم على ظلمه، لا يداهن، ولا يفرّط، ولا يساوم، يحذر التدليس والافتتان والاستدراج، ولا يركن إلى الطغاة ولا يتبع أهواءهم..
فها هو ذا الشيخ سعيد الحلبى -رحمه الله- جلس يومًا فى الجامع الأزهر، يتكئ على عمود من أعمدته، وقد مدّ رجليه ليستريح من طول الجلوس، فدخل الجامع إبراهيم بن محمد على حاكم مصر وطاغيتها، فهرع الناس لاستقباله، وبقى الشيخ سعيد على جلسته لم يتحرك، وطاف إبراهيم فى جنبات المسجد حتى مر بالشيخ سعيد، ووقف على رأسه غاضبًا، والشيخ سعيد لا يأبه به ولا يلتفت إليه، ولا يعيره اهتمامًا..
لقد انصرف إبراهيم باشا إلى قصره، وحاول أن (يزحلق) العالم الجليل، فأرسل إليه صرة من ذهب؛ يستميل بها الشيخ ويفتنه، ولما قدم سفير الباشا إلى الشيخ وأبلغه تحياته وأنه قد أرسل إليه هذه الصرة من الذهب تكريمًا له؛ وصلة للعلماء، نفر الشيخ من الصرة وكأنها ثعبان لدغه وقال للسفير: قل لإبراهيم إن الذى يمد رجله لا يمد يده».
أما الذين يتكسبون بالإسلام فلا يستطيعون خدمته، والذين يركنون للظالمين سرعان ما يزيغون عن طريق الحق، ثم ينضمون إلى فريق الضلال والنفاق، ينافحون عن الفساد، ويقبلون العيش الذليل فى حمى الفساق والفاحشين.. (وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لاَّتَّخَذُوكَ خَلِيلاً) [الإسراء: 73]، (وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاء ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ) [هود: 113].
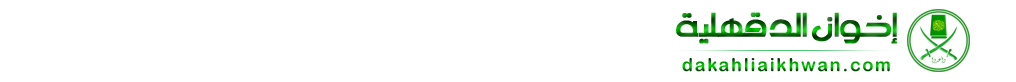 إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية



