
ارتبط القرآن العظيم بشهر الصيام ارتباطاً وثيقاً، بدأ يوم نزل بآياته أمين الوحي جبريل عليه السلام على قلب النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، ذات ليلة من ليالي شهررمضان حين كان يخلو بربه في غار حراء. قال تعالى: (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ) (185) البقرة. ومن يومها والمسلمون خصوا هذا الشهر الكريم بكثرة القراءة؛ يُحنون علي الكتاب المجيد ظهورهم، ويسابقون الزمن لختمه أكثر من مرة، كما خصته بعض الدول الإسلامية بطباعة المصحف وتوزيعه.
يقول الشيخ الغزالي :” لكن موقف المسلمين من القرآن الذي شُرفوا به يثير الدهشة ! ومن عدة قرون ودعوة القرآن مجمدة، ورسالة الإسلام كنهر جف مجراه أو بريق خمد سناه ! والأمة التي اجتباها الله تتعامل مع القرآن تاعملاً لا يجوز السكوت عليه. كان الجاهليون الأقدمون يصُّمون آذانهم عن سماعه …أما المسلمون المتأخرون فهم يسمعون وقد يتأوهون أو يسكنون، ولكن العقول مخدرة والحواس مبعثرة ومسالك الأفراد والجماعات في واد آخر، وكأنها تُنادى من مكان بعيد !!”.
والخلل الذى أصاب الأمة في التعامل مع القرآن، هو الاكتفاء بالقراءة والترتيل وسماع الألحان، واتقان الغُنن والمُدود، والانشغال بعدد الختمات؛ دون تدبر الآيات، والوقوف على معانيها، وأسباب نزولها، ومن ثم إعمال العقل الذي غاب مع حلاوة اللحن وطلاوة القراءة؛ في اكتشاف أسرار القرآن المجيد، التي لا تنقضي عجائبه، ولا يخلق عن كثرة الرد كما جاء في الحديث.
ومن هنا نفهم الأمر بالإنصات بعد الاستماع، حيث ساعد الإنصات العقل على تدبر ما يسمع، والقلب على التأثر به، وليس فقط الوقوف عند حدود الاستماع، أو ترديد الببغاوات، دون فهم أو وعي. قال تعالي:” وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (204) الأعراف. قال أبو جعفر الطبري في تفسيره : “يقول تعالى ذكره للمؤمنين به، المصدقين بكتابه، الذين القرآنُ لهم هدى ورحمة : (إذا قرئ) عليكم، أيها المؤمنون (القرآن فاستمعوا له)، أصغوا له سمعكم، لتتفهموا آياته، وتعتبروا بمواعظه، (وأنصتوا) إليه لتعقلوه وتتدبروه، ولا تلغوا فيه فلا تعقلوه، (لعلكم ترحمون) ليرحمكم ربكم باتعاظكم بمواعظه، واعتباركم بعبره، واستعمالكم ما بًّينه لكم ربكم من فرائضه في آيه”.
ولكن المبنى تضخم عندناعلى حساب المعنى، حتى رأينا لتحسين القراءة معاهد، وكثرت حلقات التلاوة، ومراكز الحفظ، وغابت حلقات التدبر في المعاني والوعي بأحكامها، والتفكر فيها، وأصبحت الأمم تقرأ لتتعلم، وأصبحنا نحن نتعلم لنقرأ!
بهذا الفهم، وهذه الرؤية في التروي والتعقل والتدبر، كان عبد الله بن مسعود سباقاً حين دعا إلى عدم الاسراع وطي الصفحات، وعد الأسطر، وتركيزهم القارئ للوصول إلى آخر السورة. جاء في كتاب أخلاق حملة القرآن للآجري:” عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَ : ” لا تَنْثُرُوهُ نَثْرَ الدَّقَلِ وَلا تَهُذُّوهُ هَذَّ الشِّعْرِ، قِفُوا عِنْدَ عَجَائِبِهِ، وَحَرِّكُوا بِهِ الْقُلُوبَ، وَلا يَكُنْ هَمُّ أَحَدِكُمْ آخِرَ السُّورَةِ “.
وقد ذمت أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها ذلك، فأخرج ابن أبى داود عن مسلم ابن مخراق ، قال: قلت لعائشة: إن رجالاً يقرأ أحدهم القرآن في ليلة مرتين أو ثلاثاً، فقالت: قرأوا ولم يقرأوا ! كنت أقوم مع رسول صلى الله عليه وسلم ليلة التمام، فيقرأ بالبقرة وآل عمران والنساء، فلا يمر بأية فيها استبشار إلا دعا ورغب، ولا آية فيها تخويف إلا دعا واستعاذ. وفي الحديث عن عبد الله ابن عمرو مرفوعاً:” لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث”.
ولما تعجب زياد بن لبيد رضي الله عنه وتساءل كيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونُقرئه أبناءنا ! في عملية توريث القراءة، فكان رد النبي صلى الله عليه وسلم عليه أنه لا ينبغي له أن يفهم ذلك. روى الإمام أحمد قال: روى النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً فقال: ” وذاك عند ذهاب العلم”، قلنا : يا رسول الله، وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا، وأبناؤنا يقرئون أبناءهم إلى يوم القيامة ؟ فقال: ” ثكلتك أمك يا لبيد، إن كنت لأراك من أفقه رجل في المدينة، أو ليس هذه اليهود والنصارى بأيديهم التوراة والإنجيل ولا ينتفعون مما فيهما بشيء”.
يقول الاستاذ عمر عبيد حسنة :” إنها الأمية العقلية التي نعيشها اليوم مع القرآن، والتي تعنى ذهاب العلم على الرغم من تقدم فنون الطباعة، ووسائل النشر، وتقنيات التسجيل …وقد تكون مشكلة المسلمين كلها اليوم في منهج الفهم الموصل إلى التدبر وكسر الأقفال من علي العقول والقلوب، وتجديد الاستجابة، وتجديد وسيلتها، ليكونوا في مستوى القرآن، ومستوى العصر، ويحققوا الشهود الحضاري، ويتخلصوا من الحال التى استنكرها القرآن :﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ (24) سورة محمد، وقوله تعالى: ﴿ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ (29) سورة ص.
وفي قوله تعالي :(وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ) (78) البقرة. قال ابن تيمية : عن ابن عباس وقتادة، أي غير عارفين بمعاني الكتاب، يعلمونها حفظاً وقراءة بلا فهم، لا يدرون ما فيها، أى تلاوة لا يعلمون فقه الكتاب، إنما يقتصرون على ما يُتلى عليهم”.
وقراءة التدبر تتطلب الارتفاع إلى مستوى القرآن، لا أن نشده إلى مستوانا نحن، يقول الشيخ الغزالي :” قرأت للعقاد مرة أن هناك ما يُسمى بشعرالحالات النفسية، وهو أن يرتقي الانسان مع الكتاب الذي يقرؤه، ويرتفع بنفسه إلى الحقائق أوالقصص أو المطالب كي يصورها. وهذا وإن كان مطلوباً مع الكتب العادية، فهو مع كتاب الله أولى…لابد من جعل القرآن يتحول في حياتنا إلى طاقة متحركة، أما أن يُوضع في المتاحف أو المكاتب للبركة، أو أن نفتح المصحف ونقرأ منه آية أو آيات وينتهي الأمر، هذا لا يجوز… وأنا سمعت من حسن البنا يقول بنفسه : لا أدري لماذا أُهمل التأليف الروائي، وكان يمكن أن يكون سبباً في أجيال واعية ؟ كان يمكن جداً أن أروي للأطفال : محاولة الحبشة هدم الكعبة تبعاً لمؤامرة عالمية بين الإمبراطورية الرومانية في أوروبا وبين الحبشة في إفريقيا، وكيف أنهم أرسلوا الفيل، وكيف أنهم نجحوا في احتلال الجنوب، وأجعل الأطفال من خلال قصة الفيل، يعرفون أشياء كثيرة من علاقات دينية، وعلاقات دولية، ومعلومات تاريخية، وكيف أن الله ينصر الإسلام بعد أن نبذل نحن جهدنا في نصرته …
يجب ألا يغيب عن بصائرنا أبداً: الهدف الأساسي الذي لابد منه وهو: كتابنا….كتابنا يكاد يضيع منا. نسمعه موسيقى من كبار القارئين، ونقرؤه بتبلد؛ لأننا نريد أن نتلاقى على مجالس تأوهات، وإعجاب بالأصوات، وانتهى الأمر…أما أن ينطلق القرآن كتاباً محركاً للحضارات، فقد غاب عنا هذا كله؛ لأننا اشتغلنا بغيره وهذا ما نرفضه”.
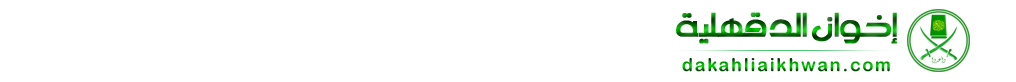 إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية



