
الحمدُ للهِ الّذي فضّلَ الأشهرَ الحرامَ على سائرِ شهورِ العامِ، وخصَّها بمزيدِ الإجلالِ والإكرامِ، وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ لهُ في ربوبيّتِه، وألوهيّتِه، وأسمائِه الحُسنى وصفاتِه العِظامِ، وأشهدُ أنّ محمّداً عبدُه ورسولُه؛ أبانَ لأمّتِه الأشهرَ الحرامَ، وحذَّرَها من الظلمِ فيها، واقترافِ الآثامِ؛ صلّى الله عليه وسلّم، وعلى آلِه، وصحبِه البررةِ الكرامِ.
أمّا بعدُ: فقد أظلَّنا في هذِه الأيّامِ ؛ شهرٌ عظيمٌ من الأشهرِ الحُرُمِ العِظامِ؛ الّتي أمر اللهُ سبحانه وتعالى بتعظيمِها، والالتزامِ فيها أكثرَ بدينِه وشرعِه، وإجلالِها؛ فقال جلّ وعلا:
﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾ [التوبة : 36]. وثبت في الصّحيحين عن سيّد المرسلين ﷺ أنّه قال:«السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا؛ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ؛ ثَلاَثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو الْقَعْدَةِ، وَذُو الْحِجَّةِ، وَالمُحَرَّمُ ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ ».
وقيل له: رجب؛ لأنّه كان يُرجَّبُ؛ أي: يُعظَّمُ، وأُضيفَ إلى مُضر، لأنّ قبيلةَ مُضـر كانت تزيد في تعظيمِه واحترامِه. وله غيرُ هذا من الأسماءِ الّتي تدلُّ على شرفِه.
وإنّ الواجبَ على المسلمِ: أن يعرفَ قدرَ هذا الشهرِ الحرامِ ؛ ذلك لأنّ معرفتَه وتعظيمَه (هو الدِّين القيِّم) أي: المستقيم؛ الّذي لا اعوجاجَ فيه، ولا ضلالَ، ولا انحرافَ. كما يجب عليه أن يحذرَ من المعصية فيه؛ فإنّها ليست كالمعصيةِ في غيرِه؛ بل المعصيةُ فيها أعظمُ، والعاصِي فيه آثمُ؛ كما قال سبحانه: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ﴾ [البقرة : 217]؛ أي: ذنبٌ عظيمٌ، وجرمٌ خطيرٌ؛ فهو كالظّلمِ والمعصيةِ في البلدِ الحرامِ؛ الّذي قال الله عزّ وجلّ فيه: ﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [الحج : 25].
ومن هنا: قال حبرُ الأمّةِ وتُرجمانُ القرآنِ عبدُ اللهِ بنُ عبّاسٍ -عليهما الرِّضوان- في تفسير قوله تعالى: ﴿فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾-كما روى الطّبريّ في (تفسيره)-: «في كلِّهنّ، ثمّ اختصَّ من ذلك أربعةَ أشهرٍ فجعلهنَّ حراماً، وعَظّم حُرُماتِهنَّ، وجعل الذنبَ فيهنَّ أعظمَ، والعملَ الصالحَ والأجرَ أعظمَ».
وعن قتادة رحمه الله قال: « إنّ الظلمَ في الشهرِ الحرامِ أعظمُ خطيئةً ووزراً من الظلمِ فيما سواهُ، وإنْ كان الظلمُ على كلِّ حالٍ عظيماً، ولكنَّ اللهَ يُعظِّمُ من أمرِه ما شاء. وقال : إنَّ اللهَ اصطفى صَفايا من خلقِه؛ اصطفى من الملائكةِ رسلاً، ومن النّاسِ رسلاً، واصطفى من الكلامِ ذكرَه، واصطفى من الأرضِ المساجدَ، واصطفى من الشهورِ رمضانَ والأشهرَ الحُرمَ، واصطفى من الأيّامِ يومَ الجمعةِ، واصطفى من اللَّيالي ليلةَ القدرِ؛ فعظِّموا ما عظَّم اللهُ؛ فإنّما تعظَّم الأمورُ بما عظَّمها اللهُ عند أهلِ الفهمِ والعقلِ».
وإنّ من أظهرِ الدلائلِ على تعظيمِ هذا الشّهرِ الحرامِ: هو الابتعادُ عن ظلمِ الإنسانِ نفسَه؛ باجتِراحِ الذنوبِ والسيّئاتِ، ومقارَفَةِ الآثامِ والخطيئاتِ؛ ذلك لأنّ الذنبَ في كلِّ زمانٍ شرٌّ وشؤمٌ على صاحبِه؛ لأنّه اجتراءٌ على اللهِ جلَّ جلالُه وعظُم سلطانُه، لكنّه في الشهرِ الحرامِ أشدُّ سوءاً وأعظمُ شؤمًا؛ لأنّه يجمعُ بين الاجتراءِ على الله تعالى، والاستخفافِ بما عظّمه اللهُ جلّ وعلا.
وإذا كان تعظيمُ الشهرِ الحرامِ أمرًا متوارَثًا لدى أهلِ الجاهليّةِ قبلَ الإسلام؛ يكفُّون فيه عن سفكِ الدَّمِ الحرامِ، وعن الأخذِ بالثّأرِ والانتقامِ؛ أفليس من ينتسبُ إلى الإسلامِ أجدرَ وأحرى بهذا الالتزامِ؟!.
كيف والظلمُ عاقِبَتُه وخيمَةٌ ، وآثارُه شَنِيعةٌ؛ فلا فلاحَ مع الظلمِ، ولا بقاءَ مع الظّلم ، مهما بلَغ شأنُ الظّالمِ؛ فقد قال اللهُ عزّ وجلّ: ﴿إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ [الأنعام:21]، وقال جلّ في عُلاه: ﴿هَلْ يُهْلَكُ إِلاَّ الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ﴾ [الأنعام:47]؛ فلاَ بقاءَ للظلمِ والاعتداءِ والطغيانِ، ولا سُلطانَ لها على الدوامِ؛ مهما طال وامتدّ بها الزّمانُ، فقد قال الملكُ العظيمُ الشَّانِ: ﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ المَصِيرُ﴾ [الحج: 48]، وثبت في الصحيحين أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّ اللهَ لَيُملِي للظَّالمِ حتَّى إِذَا أَخَذَهُ لم يُفلِتْهُ»، ثم قرأ: ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾ [هود:102].
وإذا كانت هذه عاقبةَ الظّالم في سائرِ الأوقاتِ والأزمانِ؛ فكيف بالظّالمِ المعتدِي في هذا الشّهرِ الحرامِ، وفي هذه الأيّامِ العظامِ؛ ولهذا قال النّبيّ عليه الصّلاةُ والسّلامُ في حجّةِ الوداعِ لأصحابِه -كما ثبت في الصّحيحين عن أبي بكرة رضي الله عنه-: « أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ . فَقَالَ: أَلَيْسَ ذا الحَجَّةِ؟ قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ . قَالَ: أَلَيْسَتْ بِالْبَلْدَةِ الحَرَامِ؟ قُلْنَا: بَلَى . قال: أَيُّ يَوْمٍ هَذَا ؟ قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ؛ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ. قَالَ: أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟ قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، فَسَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ ، أَلاَ فَلاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّراً -أو قال: ضُلَّالاً -؛ يَضْـرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، أَلاَ لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ؛ فَلَعَلَّ مَنْ يُبَلَّغُهُ يَكُونَ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ. ثمّ قال: أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ».
ولهذا فينبغي على المسلم أن يكون في هذا الشّهر أكثرَ ابتعاداً عن الذّنوبِ والآثامِ، وتوقِّياً لكلِّ ما يغضبُ الملكَ العلّامَ؛ فيبتعد عن ظلمِه لربِّه بالإشراك به سبحانه، وصرفِ شيءٍ من العبادةِ لغيرِه عزّ شأنُه. ويبتعد عن ظلمِه لإخوانِه بالاعتداءِ عليهم وسفكِ دمائِهم، أو أكلِ أموالِهم وحقوقِهم، أو الولوغِ في أعراضِهم، ونهشِ لحومِهم، وتتبّعِ عوراتِهم، وإفشاءِ أسرارِهم، وإلحاقِ الأذى بهم. ويبتعد عن ظلمِه لنفسِه، والإساءةِ إلى شخصِه؛ بمعصيتِه لخالقِه، وخاصّة ما يتساهلُ فيه بعضُ النّاسِ من صغائرِ الذُّنوبِ؛ فإنّ صغائرَ الذّنوبِ متى استرسل فيها الإنسانُ كان على وجهِه في النّارِ مكبوبٌ؛ إلاّ أن يتوب، وإلى ربِّه يؤوب؛ فقد ثبت في (مسند الإمام أحمد) عن سهل بن سعد السّاعديّ رضي الله عنه أنّ النّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ؛ فَإِنَّمَا مَثَلُ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ كَقَوْمٍ نَزَلُوا فِي بَطْنِ وَادٍ ، فَجَاءَ ذَا بِعُودٍ ، وَجَاءَ ذَا بِعُودٍ حَتَّى أَنْضَجُوا خُبْزَتَهُمْ ، وَإِنَّ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ مَتَى يُؤْخَذْ بِهَا صَاحِبُهَا تُهْلِكْهُ».
هذا؛ وكما أنّ المعاصيَ تعظُمُ في الشهرِ الحرامِ؛ فكذلك الحسناتُ والطّاعاتُ تعظُمُ وتُضاعفُ في هذه الأيّام ؛ فالتّقرّبُ إلى اللهِ عزّ وجلّ بالطّاعةِ في الشّهرِ الحرامِ أفضلُ وأحبُّ إليه سبحانه من التّعبُّدِ في سائرِ الأيّامِ؛ كما سبق في قول ابن عبّاس رضي الله عنهما: «وجعل الذنب فيهنّ أعظم، والعمل الصّالح والأجر أعظم».
فيستحبُّ للمسلمِ في هذا الشّهر الإكثارُ والمواظبةُ على ما ثبتت به السنّةُ في سائرِ الأيّامِ من نوافلِ الطّاعاتِ؛ من صلاةٍ، وصيامٍ، وصدقاتٍ، وغيرِها من القرباتِ ، مع المحافظةِ على الفرائضِ والواجباتِ، ولكنْ لا يشرعُ تخصيصُه بعبادةٍ من العباداتِ، أو اعتقادُ أنّ لها فضلاً في هذا الشّهرِ على سائر الطّاعاتِ؛ والحالُ أنّه لم يشـرعْها لنا فيهِ النّبيُّ عليه الصّلاةُ والسّلامُ، ولا فَعَلَها فيه صحابتُه الكرامُ رضي الله عنهم.
ذلك لأنّه رُويت أحاديثُ كثيرةٌ موضوعةٌ أو منكرةٌ ضعيفةٌ ، وأخبارٌ عديدةٌ واهيةٌ
أو ساقطةٌ تالفةٌ؛ تدلُّ على استحبابِ إحياءِ بعضِ ليالِي هذا الشّهرِ، أو فضلِ المداومةِ على الصِّيامِ، وإخراجِ الزّكاةِ في أيّامِ هذا الشّهرِ، وتلكمُ الأحاديثُ والأخبارُ لا تصلُحُ أن يعتمدَ عليها في إثباتِ مشـروعيّةِ تخصيصِ شهرِ رجبٍ بتلكَ العباداتِ؛ لأنّ العبادةَ لا تشـرعُ في الإسلامِ إلّا بدليلٍ ظاهرٍ من الكتابِ الكريمِ ، أو من صحيحِ سنّةِ خيرِ الأنامِ، وإلّا كان العملُ غيرَ مقبولٍ بحالٍ ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم -فيما رواه مسلم-: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ».
ولهذا قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في (لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف) (ص/130)- بعد أن بيّن عدمَ مشروعيّةِ اتّخاذِه عيداً وموسماً؛ كما يفعله بعضُ النّاسِ-:
«ومن أحكامِ رجبٍ: ما ورد فيه من الصَّلاةِ، والزَّكاةِ، والصِّيامِ، والاعتمارِ.
فأمّا الصَّلاةً: فلمْ يَصِحَّ في شهرِ رجبٍ صلاةٌ مخصوصةٌ تختصُّ به، والأحاديثُ المرويةُ في فضلِ صلاةِ الرَّغائبِ فِي أوّلِ ليلةِ جمعةٍ من شهرِ رجبٍ كذبٌ وباطلٌ لا تصحُّ، وهذه الصلاةُ بدعةٌ عند جمهورِ العلماءِ، وممّن ذكر ذلك من أعيانِ العلماءِ المتأخِّرينَ من الحفاظِ:
أبو إسماعيل الأنصاريُّ، وأبو بكر بن السمعانيِّ، وأبو الفضل بن ناصر، وأبو الفرج بن الجوزيِّ، وغيرِهم، وإنّما لم يذكرْها المتقدِّمون لأنّها أُحدثَتْ بعدَهم، وأوّلُ ما ظهرتْ بعد الأربعمائة؛ فلذلك لم يعرفْها المتقدِّمون، ولم يتكلَّموا فيها».
قال: «وَأَمّا الصِّيَامُ: فلمْ يَصِحَّ في فضلِ صومِ رجبٍ بخصوصِه شيءٌ عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولا عن أصحابِه».
ثمّ قال: «وَأَمَّا الزَّكَاةُ: فقدِ اعتادَ أهلُ هذِه البلادِ -يعني: بلادَ الشَّامِ- إخراجَ الزكاةِ في شهرِ رجبٍ، ولا أصلَ لذلك في السنّةِ، ولا عُرِف عن أحدٍ من السَّلفِ».
ثمّ قال: «وأمّا الاعتمارُ فِي رجبٍ: فقد روى ابنُ عمرَ رضي الله عنهما أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم اعتمَر في رجبٍ فأنكرتْ ذلك عائشةُ عليه وهو يسمعُ فسكَتَ» [أثر عائشة ’ رواه البخاريُّ في (صحيحه)].
ثمّ قال: «وقد رُوي: أنّه كان في شهرِ رجبٍ حوادثُ عظيمةٌ و لم يصِحَّ شيءٌ من ذلك فرُوي: أنّ النّبيَّ صلى الله عليه وسلم وُلِدَ في أوّلِ ليلةٍ منه، وأنّه بُعث في السَّابعِ والعشـرِينَ منه، وقيل: في الخامسِ والعشرِينَ، ولا يصِحُّ شيءٌ من ذلك، ورُوي بإسنادٍ لا يصِحُّ عن القاسمِ بنِ محمّدٍ: أنّ الإسراءَ بالنَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان فيِ سابعٍ وعشـرينَ من رجبٍ، وأنكَرَ ذلك إبراهيمُ الحربيُّ وغيرُه».
وبمثل قولِ الحافظِ ابنِ رجبٍ رحمه الله قال كثيرٌ من العلماءِ المحقِّقين؛ فقد قال قبلَه العلّامةُ ابنُ القيِّمرحمه الله في (المنار المنيف) (ص/96): «وكلُّ حديثٍ في ذكرِ صومِ رجبٍ وصلاةِ بعضِ اللَّيالِي فيهِ؛ فهُو كذبٌ مُفترى».
وحكى ابنُ السبكيِّ رحمه الله -كما في (نيل الأوطار) للشوكانيّ (4/ 331)- : «عن محمّد بن منصور السمعانيِّ أنّه قال: لم يردْ في استحبابِ صومِ رجبٍ على الخصوصِ سنّةٌ ثابتةٌ، والأحاديثُ التي تُروى فيه واهيةٌ لا يَفرحُ بها عالمٌ ».
وقال الحافظُ ابنُ حجرٍ رحمه الله في (تبيين العجب بما ورد في فضل رجب) (ص/9): «لم يردْ في فضلِ شهرِ رجبٍ، ولا فِي صيامِه، ولا صيامِ شيءٍ منه معيَّنٍ، ولا في قيامِ ليلةٍ مخصوصةٍ فيهِ حديثٌ صحيحٌ يصلحُ للحجَّةِ، وقد سبقني إلى الجزمِ بذلك الإمامِ
أبو إسماعيل الهرويُّ الحافظُ، رُوِّيناهُ عنه بإسنادٍ صحيحٍ، وكذلك رُوِّيناهُ عن غيرِه».
وقد نقل كلامَه، بل لخّص رسالتَه، وأقرّه على أحكامِه فيها: الحطّابُ الرُّعينيُّ المالكيُّ رحمه الله في (مواهب الجليل لشرح مختصـر خليل) (3/320).
وقال العلاّمةُ الشوكانيُّ رحمه الله في (السيل الجرار( (1/297): «لم يردْ في رجبٍ على الخصوصٍ سنّةٌ صحيحةٌ، ولا حسنةٌ، ولا ضعيفةٌ ضعفاً خفيفاً؛ بل جميعُ ما رُوي فيه على الخصوصِ؛ إمّا موضوعٌ مكذوبٌ، أو ضعيفٌ شديدُ الضَّعفِ».
والحاصلُ: أنّ شهرَ رجبٍ لم تثبت فيه فضيلةٌ مخصوصةٌ لعبادةٍ من العباداتِ، ولكنّ هذا
لا يعني أنّه لا يشرع فيه التّعبّدُ -لا على اعتقادِ فضيلةٍ مخصوصةٍ- بما ثبت من نوافلِ الطّاعاتِ، والأعمالِ الفاضلاتِ؛ من صلاةٍ، وصيامٍ، وصدقاتٍ، وغيرِها من القرباتِ؛ الّتي هي فيه أكثرُ فضلاً، وأعظمُ أجراً؛ لأنّه شهرٌ حرامٌ، وليس كسائرِ أشهرِ العامِ؛ ولهذا قال الإمامُ النّوويُّ رحمه الله في (شرح صحيح مسلم) (8/39): « وَلَمْ يَثْبُت فِي صَوْمِ رَجَبٍ نَهْيٌ وَلا نَدْبٌ لِعَيْنِهِ، وَلَكِنَّ أَصْلَ الصَّوْمِ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ، وَفِي سُنَن أَبِي دَاوُدَ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَدَبَ إِلَى الصَّوْمِ مِنْ الأَشْهُر الْحُرُم، وَرَجَبٌ أَحَدُهَا» [حديث أبي داود: «صم من الحرم واترك» في إسناده من لا يعرف؛ كما قال ابن حجر في (تبيين العجب) (ص/3)].
فكُنْ أيُّها الموفَّقُ لهذا الشهرِ معظِّماً، ولفضلِه مغتنِماً، وتُبْ فيه إلى ربِّك، وأقلِعْ بلا رجعةٍ عن سالِفِ خطئِك، وقبيحِ فعلِك، وأصلِحْ فيه من شأنِك، وليكن لسانُ حالِك؛ كما قال الأوّلُ من سلفِك:
بَيِّضْ صَحيِفَتَكَ السَّوْدَاءَ فِي رَجَبِ بِصَالِحِ الْعَمَلِ الُمنْجِي مِنَ اللَّهَبِ
شَهْـرٌ حَرَامٌ أَتَى مِنْ أَشْهُرٍ حُرُمِ إِذَا دَعَا اللهَ دَاعٍ فِيـهِ لَمْ يَـخِبِ
طُـوبَى لِعَبْدٍ زَكَى فِيـهِ لَهُ عَمَلٌ فَكَفَّ فِيهِ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالرِّيَـبِ
فاللّهمّ بارك لنا في رجبٍ وشعبانَ، وبلّغنا رمضانَ، ونحن في أمنٍ وأمانٍ، وسلامةٍ وإسلامٍ. اللّهمّ آمينَ، أمينَ.
والحمد لله ربِّ العالمين، وصلّى الله وسلّم على نبيّنا محمّدٍ، وعلى آلِه، وصحبِه أجمعين.
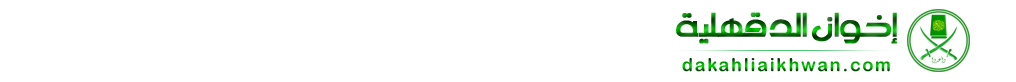 إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية



