
وائل قنديل :
ذهب المشير العجوز، حسين طنطاوي، المرشد الأعلى لسلطة انقلاب عبد الفتاح السيسي، إلى ميدان التحرير يوم الجمعة الماضي، منتشياً، محتفلاً بالانتصار على ما عرفت بثورة الغلابة.
المشير مصاب بعقدةٍ مزمنةٍ من ميدان التحرير، بدأت، منذ وقت مبكر للغاية، في أعقاب خلع حسني مبارك الذي أنعم على طنطاوي بمنصب وزير الدفاع، حين اصطفاه وزيراً للدفاع 21 عاماً متصلة (1991-2012) تشكل رقماً قياسياً في دلالته على حالة التجمّد والتبلد والتكلس التي أصابت مرحلة حسني مبارك، بالنظر إلى أن الواحد وعشرين عاماً السابقة على طنطاوي، وزيراً، استوعبت تغيير سبعة وزراء دفاع.
ميدان التحرير هو الذي أسقط المشير العجوز من أعلى السلطة، هو الميدان الذي شهد آخر حروبٍ عسكرية دولة مبارك، لانتزاع “صينية الميدان” الدائرية أو كعكته الحجرية التي خلدها أمل دنقل في قصيدةٍ، من أيدي ثوار الخامس والعشرين من يناير، ونشر قواته في “الصينية” لمنع أي متظاهرٍ من وضع قدمه على الأرض المحرّرة.
هذا الميدان هو الذي أجبر طنطاوي على تسليم السلطة التي سقطت في حجره بعد 11 فبراير/ شباط 2011 للمدنيين، بعد المذابح التي ارتكبتها قواته الأمنية بحق الثوار في أحداث شارع محمد محمود وأمام مجلس الوزراء.
هذا الميدان “العقدة التاريخية” جدير برقصة الشماتة والتشفي في دعوات “ثورة الغلابة” التي أداها المشير ذو الاثنين وثمانين عاماً، ليهتف “ها قد عدنا يا ميدان التحرير” الذي يجسّد له أسطورة أرض الميعاد، والحق الإلهي للعسكريين في السلطة.
هذا التشفي مفهوم ومبرّر من صقور الدولة العسكرية، لكنه غير مفهوم، بالمرّة، من قوى ثورية، أحيلت إلى مقاعد المتفرّجين، بعد تطوّعها في مشروع القتال لإعادة السلطة للعسكريين في 30 يونيو/ حزيران 2013، حتى وإن كانت الدعوة للتظاهر غامضةً، ومفرطةً في التفاؤل الساذج، برفع سقف التمنيات إلى حدودٍ غير منطقية.
يلفت النظر، هنا، أنه، في الليلة السابقة على تظاهرات الجمعة، جرت عملية تحويل مجرى نهر الاشتباك في وسائل التواصل الاجتماعي، إلى حرب “هاشتاغات” اندلعت فجأةً فيما بين بعض رفقاء “30 يونيو” الذين صاروا أعداء اليوم، اختطفت الكلام من النقاش حول الدعوة إلى صحارى الهجائيات والملاسنات الصاخبة، على امتداد ليلة ويوم التظاهر الذي اختفى في غبار الحرب الضروس.
وأستعيد، هنا، ما سجلته قبل ثلاثة أسابيع عن هذه الدعوة “إن أحداً لا يملك رفاهية الادّعاء بأنها ستكون ثورةً كاسحة، تسقط النظام بالضربة القاضية، غير أنه ليس من المنطقي إنكار أهميتها، من حيث المبنى والمعنى، فمن حيث المبنى يظهر أنها تجد تفاعلاً واستجابة، يثيران الخوف في دوائر السلطة، ومن حيث المعنى، فهي تجسد حقيقة أن الناس لم تعد ترى أملاً بحياة محترمة في ظل هذا النظام، وبالتالي، لا تتوقف محاولات إزاحته، وإن لم يكن التغيير في هذه المرة، فقد يأتي في مرة قادمة، وفي الإجمال: الثورة مستمرة، سواء كانت من عند النخب المثقفة، أو من لدى جموع الغلابة”.
وأزعم أنه بعد مرور اليوم (11/11) اعتيادياً وبعيداً عن حجم التوقعات، لا يزال الغموض يحيط بهذه الدعوة، ومن صناعها المختفون خلف ما تراه من صور لهذا الشاب الذي يرتدي “حطة اليسار”، ويصدر البيانات والتصريحات العابرة للقارات، والتي تصعد بالأحلام إلى القمة، لنجد المشير العجوز على أرض الميدان، محتفلا بالانتصار، ثم يخاطب المشير الصغير الشعب مهنئاً بالتغلب على الغلابة، فيما يتوارى الذين أطلقوا بيانات النفير والاحتشاد للمعركة الكبرى، والدين يتوجّب عليهم، أخلاقياً، أن يخرجوا من حالة الاختباء والكمون، خلف “واجهة الغلابة”، ويقدموا جردة حساب وتقييم لما حدث، قبل أن يدفعوا الذين يصدقونهم إلى “جمعةٍ أخرى”، يلعب فيها المشير العجوز كرة القدم على أرضية ميدان التحرير.
ويبقى أن الذين استجابوا للدعوة، على اختلاف منطلقاتهم، مازالوا يجسّدون الجوهر الأخلاقي للقضة: الصمود في مواجهة نظام احتل السلطة بالقوة المسلحة، وقتل ثورةً، وأجهض حلماً بالديمقراطية، دفعت فيه أثمان باهظة، وبالتالي، يستحق هؤلاء وسام الاحترام والفخر، ولا يستحقون أبداً، إطلاق إشارات السخرية، ولا شارات الحداد.
وأكرّر: الإصرار على تثبيت فكرة أن الثورة بلغت سن اليأس، واستراحت على أريكة العقم، وغطت في سبات اللاجدوى من التظاهر، وحرّي بها أن تتشح بالسواد، معلنةً ثالوث الإحباط الكريه: لا فائدة.. لا أمل.. لا مستقبل، هو بحد ذاته مشاركة في الحرب النفسية على الذين ينحتون في الصخر، ويتشبثون باختيار المقاومة، من دون مللٍ أو كلل، غير ناظرين إلى النتائج، تأتي مهرولةً، والثمار تتساقط في التو واللحظة.
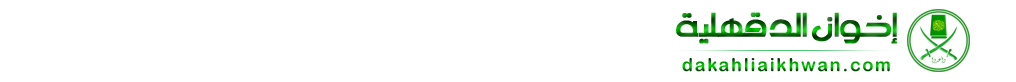 إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية



