
أربعون عاماً تفصل بين انتفاضة الخبز في يناير 1977 وبين الدعوة لما تسمى “ثورة الغلابة” 2016 في مصر، تتشابه فيها ظروف البؤس الاقتصادي والاجتماعي، وإن كانت أحوال مصر 2016 أكثر قتامة وعتمة.
في عام 1977 أقدم نظام أنور السادات على خطوة مباغتة بزيادة أسعار السلع الأساسية، سبيلاً للحصول على رضا صندوق النقد الدولي، وفي عام 2016 ذهب نظام عبدالفتاح السيسي إلى ما هو أبعد، مطلقاً الرصاص على العملة المحلية، ومشعلاً حريق الأسعار في السلع الأساسية وغير الأساسية، للحصول على قرض صندوق النقد.
في عام 1977 لم يكن السادات قد ارتمى في الحضن الصهيوني بعد، أما في حالة عبدالفتاح السيسي فهو يعيش في دفء الجنرالات والحاخامات على السواء، فيجد من يخاطب له عواصم العالم من أجل إسناده ماليًا وسياسيًّا، ولا يبخل عنه حاخامات القتل والإبادة بالدعاء، كي يحفظه الرب للشعب الإسرائيلي المختار.
موضوعيًّا، يمكن القول إن العوامل التي دفعت الشعب المصري للانفجار في وجه السادات 1977 أقل حدة، بكثير، من العوامل المتوفرة في ظل حكم عبدالفتاح السيسي، غير أن المفارقة هنا أن فرص التحرك والانفجار في ظل كارثية الأوضاع الحالية، تبدو، بنظر عديد من المراقبين، أقل، على الرغم من أنهم يتحدثون طوال السنوات العجاف التي اختطف فيها السيسي السلطة عن “ثورة جياع”.
كان السادات يصف انتفاضة الخبز ضده بأنها “انتفاضة حرامية” يقف خلفها “الشيوعيون”، إذ كان اليسار فاعلاً ومؤثرًا في معركة الوعي، ولديه الاستعداد للانحياز للجماهير، وتبدى ذلك في مشاركة فعلية في التظاهرات، والدفاع عن المعتقلين على إثرها، حتى إنها كانت من المرات النادرة التي تتم فيها مصادرة مطبوعة حكومية، هي مجلة “روز اليوسف” بسبب غلافها الصارخ في تبني مطالب الجماهير، عندما كان يرأس تحريرها صلاح حافظ.
في زمن عبدالفتاح السيسي لدينا “يسار عسكري بوليسي” يجسده رفعت السعيد، يدافع عن “تعويم الجنيه” وما يستتبعه من سياسات وإجراءات تزيد الجماهير وجعًا على وجع، متسربلاً في أزياء ياسر برهامي وحزب النور، فيما تكتفي شرائح أخرى من اليسار ببيانات رافضة للتعويم ومحذرة من العواقب.
فيما يحل “الأخوان” مكان “الشيوعيين” في خطاب النظام الأمني والإعلامي، باعتبارهم الطرف الساعي لتهيبج “البروليتاريا” واستغلال آلام الطبقات المطحونة، على الرغم من أنه لم يصدر تصريح واحد من الإخوان يحدد موقفهم بوضوح من دعوة 11/11، لكنها العقلية الأمنية المبرمجة طوال الوقت على آلية استدعاء طرف شرير، تلصق به لائحة الاتهامات بتهديد الأمن القومي والسلم المجتمعي والاستقرار.. إلى آخر هذه المصطلحات السلطوية العتيقة.
ما الذي تغير كي تبدو الجماهير على هذه الحالة من الاستكانة واليأس والانصياع للخراب؟
يمكن القول هنا إن “الشعب لم يجد من يحنو عليه” من النخب، أو الطليعة، التي تعبر بحق عن نبض هذه الجماهير، وتوجه غضبها -المشروع- ضد سياسات تحمل الخراب لمصر.
ومن المؤسف أن هذه النخب تنفق معظم طاقتها وجهدها في معارك صغيرة، بالأدوار العليا من البناء المجتمعي، حيث تصبح الرغبة في مصارعة المختلف معه سياسيًّا وأيديولوجيًّا، مقدمة على إرادة حقيقية في الحيلولة دون وقوع المجموع في هوة سحيقة، لن ينجو منها أحد، فيما يجلس النظام المسؤول عن هذه الكوارث سعيدًا مبتسمًا، راضيًا بالدور البطولي الذي تلعبه “الطليعة المثقفة” في إلزام النمل مساكنه.
وما جرى ببساطة شديدة أن احتدام الجدل والصراع بين النخب، من اليمين واليسار، بشأن دعوات التظاهر في 11 نوفمبر الجاري، بين من يتهمها بأنها لعبة مخابراتية من النظام، ومن يرى فيها مخططًا إخوانيًّا، ومن يذهب إلى أن الظروف غير مواتية للغضب، وذلك الذي يعتبرها مغامرة غير محسوبة.
كل ذلك يعبر -على وجه من الوجوه- عن انتقال النخب إلى وضعية “حزب الكنبة” في تبادل مثير للمواقع مع من كانت ترميهم بأنهم يكرهون التغيير ويحتقرون الحراك، فيستمتعون بحالة الرقود على بيض المكلمة، التي لا تفرخ إلا مزيدًا من العجز وقلة الحيلة.. ويشعلون مجددًا مواقد التدفئة على المهارشات الصغيرة، المتجددة، عن الذي خان وباع، وركب الثورة.. وبلا بلا بلا.
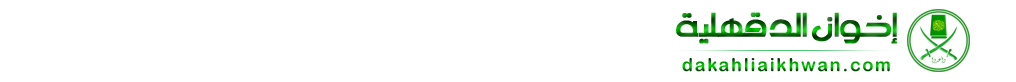 إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية



