
يراد للأزهر الشريف ومشيخته وهيئة كبار علمائه أن يكونوا كباقي فروع المؤسسة الدينية كدار الإفتاء ووزارة الأوقاف والكنيسة الأرثوذوكسية وباقي الكنائس، يراد له من جانب الطاغية عبدالفتاح السيسي وأجهزته الأمنية أن يكون مانح البركة لسياسات النظام القمعية وإضفاء مسحة من الشرعية الدينية على مواقفه السياسية الشائنة التي يمكن أن تصل أحيانا حد التواطؤ والخيانة والتفريط في السيادة الوطنية ومساندة الجبابرة والظالمين على حساب الأقليات المسلمة في عدد من دول العالم. فالنظام حريص كل الحرص على توريط الأزهر والمؤسسة الدينية بشقيها الإسلامي والمسيحي في ضلاله السياسي وتوظيفها لدعم سياساته مهما كان حد الاختلاف حولها، ومهما كان شذوذها وانحرافها، وآخر هذه الفخاخ الموقف من الدعم التركي للحكومة الشرعية في ليبيا والمعترف بها دوليا، والتي وظَّف النظام العسكري الانقلابي المؤسسة الدينية لدعم ومساندة موقفه السياسي دون اعتبار لمصالح مصر والعرب والمسلمين ودون حتى أن تقوم هذه الهيئات الدينية بوضع تصوراتها عن هذه القضية وتكييفها من زاوية شرعية؛ على اعتبار أن الحكم فرع عن تصوره كما يقول علماء الأصول؛ لكن هذه التصورات قامت بها الأجهزة الأمنية، وحيل بين المؤسسة الدينية ومناقشة هذه التصورات كما حيل بين استقلالها جبال متراكمة من الطغيان أقامها الحكام أو حتى القابلية للاستبداد من جانب شيوخ هذه المؤسسات، وكان من الأولى لهذه المؤسسات الدينية النأي بنفسها عن القضايا السياسية الشائكة باعتبارها مؤسسات علمية دعوية وليست سياسية.
يكشف الفخ الذي وقعت فيه هيئة كبار العلماء ــ رغما عنها أو بإرادتها ــ موقف سلطة السيسي وأجهزته الإعلامية من بيانين للأزهر: الأول صدر في النصف الثاني من ديسمبر 2019 حول اضطهاد الحكومة الصينية لمسلمي الأويجور، ووضع الملايين في معسكرات اعتقال لإجبارهم على ترك الإسلام. والثاني صدر في 4 من يناير 2020 لدعم موقف النظام من المساندة التركية للحكومة الشرعية ضد عدوان الجنرال خليفة حفتر الذي يتواصل منذ شهر إبريل 2019م وأفضي إلى مقتل المئات وإجبار مئات الآلاف على ترك بيوتهم ومنازلهم.
ففي حين رحبت السلطة ببيان هيئة كبار العلماء حول دعم سياسات النظام ضد تركيا وليبيا، ونشرته على نطاق واسع عبر الفضائيات والصحف والمواقع التابعة لها وعبر كتائبها الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، في سياق توظيف النظام للأزهر في خدمة أهدافه السياسية؛ فإن رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية ومديرو القنوات التلفزيونية وعددا كبيرا من الإعلاميين تلقوا تعليمات من جهازي المخابرات العامة، والأمن الوطني، بمنع نشر بيان الأزهر الشريف صباح السبت 21 ديسمبر، أو حتى التعليق عليه والذي يتضامن فيه مع المضطهدين دينياً حول العالم، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للتضامن الإنساني الذي يوافق 20 ديسمبر من كل عام. التوجيهات وصلت من ضباط بارزين في المخابرات والأمن الوطني عبر تطبيق “واتسآب”، تشدد على “منع نشر بيان الأزهر”، مبررة القرار بالعلاقات الجيدة التي تجمع بين النظامين المصري والصيني، على الرغم من أن بيان الأزهر لم يُشر صراحة إلى معاناة أقلية “الأويجور” المسلمين في الصين، وهو ما التزمت به جميع الصحف والفضائيات حتى إن موقع مبتدأ التابع لجهاز المخابرات العامة اضطر إلى حذف الخبر بعد نشره بمجرد أن جاءته التعليمات الأمنية.
ويعلم الأزهر وتعلم هيئة كبار علمائه ودار الإفتاء والأوقاف أن نظام السيسي كان قد شن حملة اعتقالات وتضييق على الطلاب الأويجور المسلمين الذين كانوا يدرسون بالأزهر الشريف حيث تم اعتقال الآلاف وترحيل المئات منهم استجابة لطلب الحكومة الصينية سنة 2018م. وهو العام الذي بلغت فيه حجم التجارة بين القاهرة وبكين حوالي 13.8 مليار دولار. ورغم أن بيان الأزهر لم يصرح مطلقا بالصين ودعا فقط احتواء الدول والحكومات للأقليات الدينية إلا أن نظام السيسي استكثر نشر بيان لدعم المسلمين المضطهدين في الصين!
والغريب أن مجلة فورين بوليسي، رصدت في تقرير مبكر لـ”روبرت سبرنجبورج” -وهو أستاذ العلوم السياسية بقسم شؤون الأمن القومي في الكلية البحرية الأمريكية وباحث متخصص في العسكرية المصرية- في سبتمبر 2014 هذا “التديين للسياسة”، يقول الكاتب إنه “يتوقع أن يستخدم السيسي الدين لإضفاء صبغة شرعية على حكمه الدكتاتوري، وهو ما لم يلحظه المراقبون الغربيون” على حد قوله. ويضيف: “أصبحت المؤسسات الإسلامية في مصر في عهد السيسي أكثر من مجرد أدوات دعم للنظام؛ بل أضحت جزءًا من الطغيان نفسه، ومن المفارقات في حملة السيسي ضد التطرف الإسلامي، أن هذه الحملة نفسها هي نوع من التطرف الديني”.
المشكلة أن هؤلاء الذين هاجموا التيارات الإسلامية وقالوا “لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين”، لا يجدون غضاضة الآن في استخدم الدين لدعم السياسات الجديدة المتبعة وتبرير القمع باسم الله، كما كانت تفعل الكنيسة في دعمها لملوك الغرب في العصور الوسطى، ولا يعترضون على “تديين” السياسة، ما يضفي هالة دينية “شرعية” على كل ما يصدر عن السيسي وحكومته.
قراءة في بيان الهيئة
بيان هيئة كبار العلماء يأتي في أعقاب رفض نظام السيسي توقيع مذكرتي تفاهم بين الحكومة التركية وحكومة الوفاق الليبية برئاسة فائز السراج. الأولى تتعلق برسم الحدود البحرية لضمان حقوق البلدين في ثروات الغاز الضخمة التي يضمها شرق البحر المتوسط، وهي الاتفاقية التي تصب أساسا في صالح مصر وترد لها 7 آلاف كم مربع على الأقل من حقوقها البحرية التي تمتلئ بالغاز والتي تنازل عنها السيسي للصهاينة والقبارصة واليونانيين، ولا تمس مطلقا حدودها البحرية كما صرح مسئولون بحكومة السيسي. والثانية تتعلق بالتعاون العسكري، لدعم الحكومة الشرعية ضد عدوان الجنرال الدموي خليفة حفتر المدعوم من تحالف الثورات المضادة في مصر والسعودية والإمارات إضافة إلى فرنسا. وفي أعقاب موافقة البرلمان التركي الخميس 2 يناير2020 على طلب الحكومة إرسال قوات عسكرية إلى طرابلس لدعم حكومة الوفاق المعترف بها دوليا ثارت ثائرة عواصم تحالف الثورات المضادة في القاهرة والرياض وأبو ظبي.
وإذا كانت المخاوف من توريط المؤسسة العسكرية المصرية في ملف ليبيا استحوذ على كل المراقبين والمهتمين بالشأن السياسي في أعقاب حملة الدعاية الواسعة التي شنتها الآلة الإعلامية لنظام 30 يونيو العسكري من أجل التسويق لتدخل عسكري في ليبيا تحت مزاعم الدفاع عن الأمن القومي، فإن النظام قد ورط بالفعل المؤسسة الدينية في سيل من الفتاوى والبيانات السياسية التي تنحاز لقرار السلطة وتبرر تصرفها وتضفي عليه مسحة دينية تبارك هذه السياسيات بعيدا عن مدى مشروعيتها أو حتى مناقشة ما يمكن أن تحققه من مصالح أو تلحقه من خسائر للبلاد؛ وذلك في إطار تصعيد الحملة على تركيا والمبالغة في العداء حدا افتعال معركة وهمية ضمن إطار السياسات الهروبية للنظام من مواجهة تداعيات الفشل في ملف سد النهضة الذي يهدد الأمن القومي المصري بعنف وشدة، وكذلك للتغطية على فشل النظام في كثير من الملفات السياسية والاقتصادية الأخرى.
الجديد في مسألة توريط المؤسسة الدينية هذه المرة وتوظيفها سياسيا لإضفاء مسحة دينية على سياسات النظام وشرعنتها وإكسابها بعدا دينيا هو توريط هيئة كبار العلماء التابعة للأزهر الشريف، والتي طالما نأت بنفسها عن التورط في الصراعات السياسية، تاركة هذا الدور المشبوه لدار الإفتاء ووزارة الأوقاف. وأصدرت الهيئة بيانا بتاريخ السبت 4 يناير 2020، اشتمل عدة مضامين وتوجهات داعمة للسلطة بلا خلاف:
أولا: أبدت الهيئة دعمها لموقف النظام إزاء الموقف من ليبيا وإعلان تركيا دعمها لحكومة الوفاق الشرعية ضد عدوان الجنرال خليفة حفتر، وهو ما يمكن اعتباره شيكا على بياض ليفعل النظام ما يشاء بدءا من بيانات الاستنكار والإدانة وصولا إلى الدعم والمساندة لمجرم الحرب خليفة حفتر حتى التدخل عسكريا بشكل مباشر؛ حيث كشفت الهيئة في بيانها عن دعمها، لموقف النظام بدعوى الحفاظ على أمن مصر وسلامتها، وأمن المنطقة بأكملها، وتحليه بأقصى درجات الدبلوماسية، مدعية أن هذا الموقف ليس بجديد على مصر التي كانت ولا تزال سدا منيعا ضد العبث بأمن الشعوب العربية والإسلامية وسلامتها.
ثانيا: أعلنت رفضها أي تدخل أجنبي على الأراضي الليبية. واعتبرت “أي تدخل خارجي على الأراضي الليبية هو فساد في الأرض ومفسدة لن تؤدي إلا إلى مزيد من تعقيد الأوضاع في ليبيا، وإراقة المزيد من الدماء وإزهاق الأرواح البريئة”. وهي صياغة عامة وفضفاضة لم تشر مطلقا إلى تركيا لكن توقيت صدور البيان لا يعفي الهيئة من استخدامها وتوظيفها سياسيا لخدمة أهداف النظام. الأمر الآخر هو أن تدخلات الإمارات ومصر وفرنسا وروسيا في الشأن الليبي سافرة إلى حد مشين، وتسبب ذلك في سفك الآلاف من دماء الأبرياء؛ فلماذا لم تدن الهيئة هذه النوعية من التدخل الأجنبي؟ كما غضت الهيئة الطرف ليس فقط عن تدخل نظام السيسي السافر في ليبيا، بل تجاهلت عمدا دعمه لمجرم الحرب خليفة حفتر الذي يواصل سفك الدماء الحرام منذ سنوات في صراعه ضد حكومة شرعية معترف بها دوليا! ألا تعلم الهيئة الموقرة أن الركون إلى الظالمين سبيل ممهد إلى عذاب الله كما نصت آيات القرآن الكريم. إضافة إلى ذلك أن البيان “طالب العالم أجمع وفي مقدمته الدول الإسلامية والمؤسسات الدولية المعنية بحفظ السلم والأمن الدولي، منع هذا التدخل قبل حدوثه، ورفض سطوة الحروب التي تقود المنطقة والعالم نحو حرب شاملة”، فلماذا لم تطالب الهيئة نظام السيسي التوقف عن دعم خليفة حفتر الذي يرفض الانخراط في تسوية سياسية للأزمة مصرا على الانفراد بالحكم وحيدا لاستنساخ تجربة السيسي في ليبيا وتأسيس نظام حكم عسكري شمولي اتساقا مع مواقف النظم العربية وتحالف الثورات المضادة؟
ثالثا: رفض البيان الذي أصدرته الهيئة “منطق الوصاية الذي تدّعيه بعض الدول الإقليمية على العالم العربي، وتتخذه ذريعة لانتهاك سيادته، والتأكيد على أن حل مشكلات المنطقة لا يمكن أن يكون إلا بإرادة داخلية بين الأشقاء”. وهو كلام صحيح لكنه يتجاهل عدة أمور: الأول: الفراغ الذي تركه العرب في ليبيا لسنوات.
الثاني: عندما تنبه العرب للأزمة انحازوا إلى طرف على طرف وللأسف فإن الطرف الذي انحازوا إليه مجرم حرب مطلوب للعدالة الدولية.
الثالث: أن عواصم تحالف الثورات المضادة يستهدف إقامة مذابح جماعية مروعة للإسلاميين في ليبيا على غرار ما فعل السيسي في مصر في إطار مساعيهم لوأد أي تطلعات شعبية نحو التحرير والاستقلال وإقامة نظام حكم رشيد يقوم على صناديق الاقتراع لا صناديق الذخيرة.
رابعا: إلى جانب بيان الهيئة نشرت صحف ومواقع النظام وقنواته الفضائية تصريحات للدكتور صلاح العادلي أمين عام كبار العلماء دعا فيها إلى أهمية المساندة الوطنية للدولة الليبية ضد ما وصفه بالعدوان الخارجي ودعم موقف مصر لحفظ أمن المنطقة! وهو تبني مطلق لرواية النظام على ما به من أكاذيب وبهتان، إذ يفترض الشيخ الجليل أن مجرم الحرب حفتر هو ممثل الدولة الوطنية الليبية بينما لا يعترف بالحكومة الشرعية المعترف بها دوليا! ولا يتوقف جهله عند هذا الحد بل يريد أن ينتزع من هذه الحكومة الشرعية حقها في إبرام العهود والاتفاقيات من أجل ضمان وحماية مصالح الشعب الليبي وثرواته في غاز المتوسط والحيلولة دون إقامة نظام عسكري مجرم على غرار نظام السيسي في مصر، أو حتى الاستعانة بقوة إقليمية لمواجهة عدوان مجرم الحرب حفتر المدعوم من القاهرة والرياض وأبو ظبي.
خامسا: افتراض عدم البراءة في بيان الهيئة ليس فقط في التوقيت، ولكن أيضا باعتباره جزءا من حملة واسعة تشرف عليها أجهزة السيسي الأمنية والتي هبت في عاصفة من التجييش والحشد ضد تركيا وحكومة الوفاق جندت فيها الإعلام والمؤسسة الدينية والخارجية وكتائبها الإلكترونية. وكانت مصادر أمنية قالت في وقت سابق إن الجهات الأمنية المسئولة عن وسائل الإعلام طلبت من الصحفيين والفنانين حث المصريين وتجييشهم “للاصطفاف حول القيادة السياسية، حال نشوب حرب بين مصر وتركيا على الأراضي الليبية”. هذه الحملة التي يشرف عليها جهاز المخابرات العامة تعتمد على بث الشائعات والأكاذيب، وحرضت الممثلين والممثلات ولاعبي الكرة على نشر ادعاءات والحديث عن أن “تركيا تستهدف احتلال مصر وكسر هيبة الجيش المصري في المنطقة، عبر إرسال وحدات من جيشها إلى ليبيا”. وطالبت المخابرات كتائبها الإلكترونية باتهام أي شخص يرفض قرار الحرب بـ”الخيانة والعمالة، ويجب نبذه بل والإبلاغ عنه حال اقتضى الأمر”.
سادسا: لم يختلف موقف الأوقاف عن الأزهر، حيث بادر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المقرب جدا من الأجهزة الأمنية بإصدار بيان، اعتبر فيه أن واجب الوقت يحتم على جميع المصريين أن يكونوا صفًا واحدًا، وعلى قلب رجل واحد خلف السيسي، والقوات المسلحة والشرطة المصرية والدولة الوطنية، وهو ما ندين به لله عز وجل تدينا ووطنية». والعبارة الأخيرة تصبغ هذا الموقف السياسي بصبغة دينية لا تقبل الاختلاف، فمن عارض موقف النظام فقد خالف الدين وانتفت عنه صفة الوطنية؛ وهي صورة شديدة الدلالة على مدى ما تمارسه المؤسسة الدينية التابعة للنظام من تكفير ديني وسياسي ووطني يفوق حتى ما تفعله تنظيمات الإرهاب مثل داعش وولاية سيناء وغيرها. وحول التكييف الشرعي لهذه التصريحات الشاذة فقد أبدى الوزير اطمئنانه التام وثقته المطلقة في حسن تقدير الرئاسة والجيش للأمور!.
سابعا، موقف مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء «السيسية» كان سياسيا بامتياز متحدثا عن ما مزاعم حول ما سماها بالأطماع التركية ودعمها لما وصفه بالإرهاب ونشر الفوضى في ليبيا كما حدث في سوريا! وهو بيان يبدو من تحليل مضمونه أن كاتبه هو ضابط مخابرات أو أمن دولة، ذلك أن من نشر الخراب في ليبيا هو سفاحها بشار الأسد الذي رفض النزول على رغبة الجماهير والاكتفاء بالسنوات الطويلة التي حكمها، وقرر قتل كل رافضيه وهم بالملايين، ولما حاصرته الهزائم استعان بالروس والإيرانيين ومليشيات حزب الله ولم يتورع عن استخدام كل الجرائم في سبيل بقائه في السلطة، وباتت سوريا الآن مرتعا للاحتلال الروسي والقواعد الأمريكية والقوات والمليشيات البريطانية والفرنسية والإيرانية، ولم يجد السوريون حضنا دافئا يستقبلهم إلا تركيا أردوغان. وفي ليبيا اليوم لا يضع العراقيل أمام التسوية السياسية إلا الجنرال الدموي خليفة حفتر المدعوم من نظام السيسي وتحالف الثورات المضادة.
السيسي و داعش وجهان لعملة واحدة
واقع الأمر أنه لا فرق مطلقا بين ما فعله السيسي (ولا يزال) في رابعة والنهضة وغيرها من مذابح دموية اتسمت بأعلى درجات الوحشية واللاإنسانية، وما فعله (ولا يزال) تنظيم داعش في المصلين بمسجد الروضة بشمال سيناء وغيرها من مذابحه الوحشية؛ فكلاهما يجرم وكلاهما يبرر جرائمه بخطاب ديني وفتاوى شيوخه!
ولم تشهد مصر فترة مثل تلك التي أعقبت انقلاب 3 يوليو (تموز) 2013، في توظيف السلطة للمؤسسة الدينية وخطابا دينيا تبريرا لجرائمها ومواقفها المشينة، واضطلعت المؤسسة الدينية الرسمية وشيوخها أو كهنتها بجزء كبير من تلك المهمة في تديين الخطاب السياسي. ومن أبرز هذه الشواهد التسريبات التي جرت في أكتوبر 2013، حيث وقف المفتي السابق والشيخ الصوفي الشهير علي جمعة، أمام قادة الجيش والشرطة، وفي مقدمتهم رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي ليقول: «لقد تواترت الرؤى بتأييدكم من قبل رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ومن قبل أولياء الله»، وأخذ يردد بحماسة: «الدين معك والله معك والرسول معك والمؤمنون معك». لم يدع جمعة مجالًا لأية معارضة للطريق الجديد الذي يتشكل؛ فتلك المعارضة لن تكون بحسبه معارضة لبشر، وإنما هي معارضة للاختيار النبوي واختيار الأولياء، الذي تجلَّى في الأحلام الليلية، كما قال جمعة.
وحتى مشهد انقلاب 3 يوليو نفسه، تعمد النظام إضفاء مشروعية دينية على أبشع جريمة ارتكبت بحق مصر وثورتها خلال القرون الماضية، وذلك بإضفاء مشروعية على جريمة الانقلاب على النظام الشرعي المنتخب بإرادة الشعب الحرة، واختطاف مؤسسات الدولة لحساب عصابة من كبار الجنرالات ثبت بعد ذلك أنه ذراع لقوى إقليمية نافذة على رأسها الكيان الصهيوني والسعودية والإمارات برعاية أمريكية خالصة رأت في نجاح الديمقراطية بمصر تهديدا لوجود “إسرائيل”. وبين 14 شاركوا في بيان الجريمة كان هناك شيخ الأزهر أحمد الطيب وتواضروس الثاني بابا الكنيسة الأرثوذوكسية وجلال المرة، الأمين العام لحزب النور السلفي، الذي يحظى برعاية أمنية خاصة. وفي أعقاب كلمة السيسي مباشرة ألقى الطيب وتواضروس كلمتين لإضفاء البركة والمشروعية على بيان الانقلاب الذي اختطف مصر لحساب عصابة وشبكة مافيا تعمل لحساب قوى دولية وإقليمية بعيدا عن الشعب الذي تم عزله عن صناعة القرار بعد سنتين من أجواء ديمقراطية غير مسبوقة.
وقبل مسرحية 2018م الرئاسية، عندما أطاح السيسي بكل منافسيه، وحول المشهد إلى أضحوكة حيث تبارت أجهزته الأمنية في البحث عن منافس صوري للجنرال في سباق مسرحي معلوم النتائج مسبقا؛ أصدرت عشرات الشخصيات السياسية ومئات النشطاء بيانا يوم 28 يناير2018م، طالبوا فيه بـ”وقف الانتخابات، واعتبارها فقدت الحد الأدنى من شرعيتها، ووقف أعمال الهيئة الوطنية للانتخابات، وحل مجلسها؛ لأنه تستر على تدخل أمني وإداري في الانتخابات المفترضة”. لكن المؤسسة الدينية تعاملت مع الموقف باعتبارها حزبا سياسيا لا مؤسسة دينية يجب أن تتسم بالاحترام والوقار؛ فـ«أصدرت دار الإفتاء فتوى بتحريم الاستجابة إلى دعوات المقاطعة التي تقودها جبهات المعارضة، مؤكدة أن الممتنع عن أداء صوته الآن يعد آثماً شرعا، فيما قال المفتي بحرمة مقاطعة الانتخابات». وفي السياق ذاته، «وصف الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، من لم يذهب للتصويت في الانتخابات القادمة “بالخيانة”، وأن المشاركة في الانتخابات أمانة، والله أمرنا بأداء الأمانة، والبخل بأدائها خيانة لهذا الوطن، والله لا يحب الخائنين». ودعم المجلس الأعلى للطرق الصوفية للجنرال السيسي لا يحتاج إلى برهان، فالشيخ عبدالهادي القصبي رئيس المجلس وعضو البرلمان في ذات الوقت، طاف المحافظات مشاركا في مؤتمرات دعم الجنرال داعيا إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات، واعتبر الداعين للمقاطعة يهدفون إلى إسقاط الدولة. واعتبر الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، الداعين إلى مقاطعة مسرحية الرئاسة خونة للوطن وأعداء له، وهدفهم هدم الوطن، كما دعا ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، إلى المشاركة بكثافة.
جدلية العلاقة بين الدين والدولة
واقع الأمر، أنه ليس صحيحا أننا نعانى من تدخل الدين في السياسة، لأن العكس هو الصحيح في مصر. ذلك أن المؤسسات الدينية ــ وليس الكنائس وحدها ــ تراجعت قوتها وجرى إضعافها ضمن الضعف الذي أصاب جميع مؤسسات المجتمع وفاعلياته، لذلك فإنها تحولت إلى مجرد ديكور في المشهد السياسي. فتاريخيا، فإنه كلما قويت شوكة السلطة المركزية، بحيث بسطت سلطانها على المجتمع وتغولت فيه، ازدادت جرأتها على توظيف الدين لصالحها. وكان ذلك التغول من سمات الدولة المصرية الحديثة التي شرع محمد على باشا والى مصر في تأسيسها في بداية القرن التاسع عشر. إذ قبل ذلك التاريخ، كانت المؤسسة الدينية ممثلة في الأزهر قوة روحية وسياسية في الوقت ذاته. إذ كان الأزهر قلعة مقاومة الاحتلال الفرنسي في ثورتي القاهرة عامي ١٧٩٨ و١٨٠٠. وظل سند المظلومين في مواجهة عسف أمراء المماليك. وحين استمرت المظالم وزادت الضرائب في عهد الوالي التركي خورشيد باشا، فإن علماء الأزهر هم من رفعوا شكايتهم إليه، وحين لم ينتصح فإنهم أعلنوا التمرد عليه وقادوا محاصرته في القلعة إلى أن استسلم. وأرغم الخليفة العثماني على تولية محمد على حكم مصر وخلع خورشيد باشا. فقام نقيب الأشراف السيد عمر مكرم وشيخ الأزهر عبدالله الشرقاوى بإلباسه خلعة الولاية في عام ١٨٠٥، بعدما اشترطوا عليه أن يحكم بالعدل وإلا تم عزله. علماء الأزهر آنذاك لم يتصرفوا بحسبانهم وعاظا ولا سلطة دينية، ولكنهم كانوا جزءا من النخبة الوطنية التي تصدت للظلم وانحازت إلى الشعب واستقلاله، في بواكير الحركة الوطنية المصرية.
لكن محمد على باشا الذي أدرك قوة المؤسسة الدينية لجأ إلى إضعاف الأزهر حين أراد الانفراد بالسلطة. ولجأ في ذلك إلى التفنن في السيطرة عليه بوسائل عدة فصَّلتها الدكتورة ماجدة على صالح ربيع في رسالتها للدكتوراه وكتابها الذي صدر في عام ١٩٩٢ بعنوان «الدور السياسي للأزهر». رصدت الدراسة السابقة أطوار سيطرة السلطة على الأزهر. التي انتهت بتأميمه وتحويله إلى مؤسسة تتولى «تعبئة الأفراد لتأييد سياسة الحاكم»، وهى العبارة التي ختمت بها الدكتورة ماجدة الفصل الخاص بالقضاء على استقلال الأزهر.
الأمر الآخر أنه في الفكر الإسلامي والتجربة الإسلامية لا توجد “كنيسة” كما لا توجد مؤسسة دينية كهنوتية، وبالتالي فكرة العلمانية لم تكن مطروحة في السياق الحضاري الإسلامي، لأن وجه الخطر فيها غير مطروح، وكان الفقهاء والعلماء لهم حريتهم وفضاؤهم الواسع المباشر مع الناس، ولهم موقعهم المتباعد عن السلطة، بل هناك أدبيات كثيرة في التراث الإسلامي تحذر من اقتراب العالم من السلطان، غير أن ظهور الدولة القومية الحديثة، أنهى هذه الاستقلالية، وأنتج في دول العالم الثالث المسلمة ظاهرة المؤسسة الدينية وما يشبه الكهنوت الديني الذي يخضع لسيطرة السلطة وتستخدمه السلطة لتعزيز هيمنتها وقهرها للناس، وهو الأمر الذي يستوجب اجتهادا جديدا وشجاعا في الفكر الإسلامي، لرفع الإصر عن الناس، وتحريرهم من هذا “الكهنوت” الديني المبتدع، والذي يعوق تطلعات الشعوب للحرية والكرامة والنهوض، وتحرير الإسلام ذاته من تغول السلطة المستبدة التي صنعت المؤسسة الدينية لتكون خادما لها ومبررا لطغيانها وجرائمها ودعما لبقائها في السلطة قهرا واستبدادا.
وبحسب الكاتب الكبير فهمي هويدي فقد أثبتت التجربة فشل فكرة الفصل بين الدين والدولة، ناهيك عن تعذر ذلك الفصل من الناحية العملية، خصوصا في المجتمعات التي يتجذر فيها الشعور الإيماني، لذلك فإن التحدي الحقيقي يتمثل في كيفية صياغة تلك العلاقة بصورة متوازنة تحول دون طغيان كل طرف على الآخر. بحيث لا توظف الدولة الدين لصالحها، ولا تتحكم المؤسسات الدينية في سياسة الدولة. والصيغة المطروحة للحفاظ على ذلك التوازن تقوم على عنصرين: أولهما: التمييز بين الدين والسياسة واحترام حدود كل منهما من ناحية، وثانيهما: الالتزام بقيم الديمقراطية والحرية التي تحمى المواطنة وتضمن المشاركة وتقوى حضور المجتمع بمختلف مؤسساته المدنية والدينية، بما يحول دون تغول السلطة واستبدادها.
خلاصة الأمر، أن هذه الفتاوى السياسية من المؤسسة الدينية الرسمية تثير كثيرا من المخاوف على مستقبلها؛ لما لذلك من تأثيرات اجتماعية ضارة؛ وإصرار السلطة على توظيفها لخدمة الحكام له تداعيات خطيرة على التدين عموما، وأن السلطات السياسية والأجهزة المعنية مطالبة برفع يدها عن الأزهر ودار الإفتاء والمؤسسات الدينية الرسمية، وأن لا ترهقها وترهق القائمين عليها بإجبارهم على دعمها ومساندتها باستمرار للقرار السياسي، فهذا ـ وإن بدا مفيدا لها في المدى القصير ـ فإنه مضر جدا على المدى الطويل، لأنه يهدر حرمة تلك المؤسسات الدينية ومصداقيتها ويضعف القبول بها كمرجعية دينية يتقبلها الناس عند الخلاف، وهو ما جرى بالفعل. بل إن توريط المؤسسة الدينية في الضلال السياسي في حد ذاته يساعد على التطرف والفوضى الدينية لأنه يعطي المبرر لداعش وغيرها بتوظيف الفتوى الدينية واستخدامها لإضفاء مشروعية على مواقفها في ظل الفراغ الديني القائم وفقدان الثقة في المؤسسة الدينية وشيوخها الذين كانوا أجلاء قبل الانحياز للسلطة والتورط في ضلال السياسة ودعم الانقلاب الدموي على ثورة يناير 2011م في مصر.
لكن الأكثر خطورة على الإطلاق ما أشار إليه الدكتور سيف عبدالفتاح في دراسته “الزحف غير المقدس” مؤكدا أن «السلطة العسكرية في مساعيها نحو تكريس استبدادها اتجهت نحو “احتكار الدين”، من خلال الانفراد بسلطتي الانتقاء والتأويل، وهو ما يعني أن الدولة – من خلال مؤسساتها الدينية الرسمية- قد مارست سلطة اختيار نصوص دينية معيّنة يتم وضعها في حيز الاهتمام والتركيز. كما أنها أيضاً قد قامت بتأويل النصوص الدينية بالشكل الذي يتناسب مع توجهاتها وأهدافها الكلية». وهو ما يوجب على الغيورين تحرير الإسلام من قبضة السلطة.
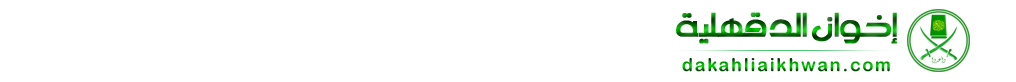 إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية



