
تمر اليوم الإثنين 11 فبراير 2019م، الذكرى الثامنة لتنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في أعقاب الموجة الأولى من ثورة 25 يناير 2011م، حيث أطل عمر سليمان، نائب الرئيس الأسبق وقتها ورئيس جهاز المخابرات العامة، على شاشة التلفزيون الرسمي معلنًا عن تنحي مبارك وتكليف المجلس العسكري بإدارة البلاد!.
وبعد البيان مباشرة، عمت الفرحة أرجاء البلاد وجاءت سكرة النصر لتذهب بالعقل، وانضم للميدان فلول النظام وأعداء الثورة مدعين أنهم ثوار، وشاركوا في الثورة من يومها الأول؛ وكان أول أعداء الثورة التحاقا بها للالتفاف عليها ووأدها هو المجلس العسكري الذي كلفه مبارك بإدارة شئون البلاد، فكيف يتنحى ويكلف في ذات الوقت؟! وهل يحق لمن أطاحت به ثورة أن يكلف من يحكم البلاد بعده؟.
بداية الانقسام
كان الثوار في موقف عصيب، واختلفت الآراء بين من يرون إنهاء الاعتصام في ميدان التحرير عند هذا الحد والبناء على ما تحقق من إنجاز بوسائل أخرى، خصوصًا أن قطاعا لا يستهان به من الشعب كان يرى أن استمرار الاعتصام معوق لمسيرة البلاد، كما صوره إعلام مبارك. بينما طالب فريق آخر بضرورة البقاء في الاعتصام والمطالبة بتسليم الحكم للمدنيين واستكمال باقي مطالب الثورة بالضغط بالاعتصام.

كلا الرأيين له وجاهته: فالأول تعامل بواقعية، إذ أن الضغط على مبارك أفضى إلى إسقاطه وإسقاط ملف التوريث داخل الأسرة، وحل مجلس الشعب الذي جاء بالتزوير الفج والإطاحة بعدد من أركان النظام ومراكز القوى، ومزيد من الضغط كان ربما يؤدي إلى الصدام المبكر مع المؤسسة العسكرية في ظل ترديد شعارات مثل “عاوزين إيه تاني مش مبارك مشي خلاص؟ إنتم عاوزين تخربوا البلد؟) إضافة إلى ما كان يتمتع به الجيش في ذلك الوقت من شعبية لا يستهان بها، في الوقت الذي تآكلت فيه تمامًا شعبية مبارك.
الرأي الآخر كانت له وجاهته النظرية، وكان التشكيك المبكر في نوايا المجلس العسكري صائبًا إلى حد بعيد، ولعل الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل كان صاحب التشكيك المستمر في نوايا المجلس العسكري، حتى وصفهم بالثعالب الماكرة، وهو ما كشفت الأيام والسنوات عن دقة صوابه؛ لكن في هذا التوقيت في يوم تنحي مبارك، لم تكن الثورة تملك الأدوات التي تمكنها من الإطاحة بالمجلس العسكري دون صدام عنيف، وهو ما يعني أن ما جرى في ميادين رابعة والنهضة وقبلها مجلس الوزراء ومحمد محمود والعباسية كانت ستتم في ميدان التحرير؛ إذا أصر الثوار على مطالبهم بتسليم الحكم سريعًا للمدنيين.
العسكر ودق أسافين الفتنة
وكان من أبرز عقبات هذا الطرح أيضًا، رغم وجاهته، أن الثوار أنفسهم كانوا منقسمين ولم يكن ثمة توافق على تشكيل مجلس رئاسي مدني يضم الأطياف التي شاركت في الثورة من إسلاميين وعلمانيين؛ فقد كان كل فريق يرى أن دوره في الثورة أعلى من الآخر، ما يسمح له بقيادة المرحلة المقبلة، وهو الانقسام الذي عمل المجلس العسكري على تكريسه وإكسابه بعدا أيديولوجيا بطرح استفتاء 19 مارس على عدة مواد أساسية في دستور 1971م. وهو الاستفتاء الذي عمق الانقسام بين قوى الثورة على المستويين السياسي والأيديولوجي.
على المستوى السياسي، انقسم الثوار إلى فريقين: الأول يرحب بهذه التعديلات باعتبارها خطوة على المسار الديمقراطي وخريطة طريق واضحة المعالم نحو تسليم السلطة للمدنيين تبدأ بالاستفتاء، ثم انتخابات برلمانية تشمل مجلس الشعب والشورى مع فتح باب تشكيل الأحزاب السياسية، وينتخب البرلمان لجنة تأسيسية لسن دستور جديد للبلاد، ما يعني تحقيق مطلبين مهمين للثورة: الأول انتزاع السلطة التشريعية من المجلس العسكري. والثاني تحقيق رقابة شعبية على حكومات المجلس العسكري التي كانت تمارس أعمالها دون أي رقابية شعبية. إضافة إلى أن هذا المسار سوف يفضي إلى انتخاب لجنة تأسيسية عبر البرلمان المنتخب من الشعب. وهو المسار الذي جاء تحت لافتة “الانتخابات أولا”.
الفريق الثاني: رفض هذا المسار تحت شعار “الدستور أولا” ؛ متهما الفريق الأول ومعظمهم كان من الإسلاميين بأنهم يريدون الاستئثار بالحكم باعتبارهم الأكثر جاهزية للانتخابات؛ ورغم وجاهة الطرح بضرورة إسقاط دستور مبارك كاملا وتأسيس دستور جديد ثم بناء باقي المؤسسات، إلا أن هذا الطرح جاء متناقضا وافتقد إلى الواقعية؛ إذ كيف سيتم تشكيل اللجنة التأسيسية، هل بالانتخاب أم بالتعيين من جانب المجلس العسكري؟ فكان ردهم بالانتخابات طبعا.. وبذلك نعود إلى فكرة “الانتخابات أولا” مع صعوبة انتخاب مائة للجنة التأسيسية على مرحلة واحدة، بينما اختيارها على مرحلتين (البرلمان ثم ينتخب هو التأسيسية) كان الأكثر واقعية واتساقا.

الأكثر دهشة أن هذا الفريق الذي عارض الانتخابات أولا هو نفسه الذي بدأ بالانتخابات بعد انقلاب 03 يوليو 2013م، حيث تمت مسرحية الرئاسة أولا منتصف 2014م، ثم الدستور في يناير 2015م، ثم البرلمان في أواخر 2015م. إضافة إلى ذلك فإنهم استفردوا تماما بوضع دستور 2014م في ظل إقصاء كامل للإسلاميين من المشهد السياسي بمباركة وتحريض هذه القوى “العلمانية”؛ بل مباركة المذابح الدموية وتبريرها بحق الإسلاميين، ولم يلتزم النظام بهذا الدستور؛ حيث استخف به وداس عليه ويعمل على ترقيعه وتطويعه ليكون ملبيا لنزعات الاستبداد والديكتاتورية التي يتصف بها جنرال الانقلاب عبدالفتاح السيسي وأركان حكمه الفاشي.
دروس الوعي
من أول دروس الوعي في هذه الذكرى، أن معادلة الحكم في مصر معقدة، وتتداخل فيها أطراف دولية مؤثرة، وذلك استنادا إلى حجم مصر ودورها وقربها من الكيان الصهيوني، وحجم تأثيرها الهائل في المنطقة والإقليم كله. ومن السطحية أن نظن أن الثورة وحدها كانت سببًا في الإطاحة بمبارك؛ بل تكاتفت عدة عوامل أسهمت في الإطاحة بالرئيس الأسبق على رأسها الموجة الأولى للثورة، والتي وظفها المجلس العسكري لحماية مصالح المؤسسة العسكرية فتمت الإطاحة برأس النظام لحماية النظام ذاته، ما يعني أنه تمت الإطاحة بمستبد ولكن بقيت منظومة الاستبداد التي تقودها المؤسسة العسكرية وشبكة المصالح الواسعة التي يتم وصفها بالدولة العميقة. وأن الديمقراطية الحقيقية لن تتحقق في مصر مطلقا في ظل هيمنة المؤسسة العسكرية على جميع مفاصل البلاد واستمرار وصايتها على الشعب والوطن وجميع مؤسسات الدولة.
ثانيا: يحتاج الإسلاميون إلى الوعي بطبيعة معادلة الحكم القائم في مصر ومدى النفوذ الواسع الذي تحظى به الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في صناعة القرار بمصر، فقد حققت واشنطن اختراقًا واسعًا في الصفوف الأولى للمؤسسة العسكرية المصرية منذ اتفاقية كامب ديفيد 1978م، وعبر المعونة الأمريكية والمساعدات العسكرية، يمكن الجزم بأن واشنطن اشترت ولاء معظم القادة والجنرالات الكبار، وجندت الكثيرين منهم لخدمة مصالحها وضمان حماية أمن الكيان الصهيوني؛ ما يعني عدم قبول هذه القوى لأي حكم إسلامي النزعة والتوجه، بل خوف هذه القوى من تأسيس أي نظام ديمقراطي حقيقي من الأساس؛ لأن ذلك من شأنه نسف السيستم القائم وبناء “سيستم” جديد، وتغيير آليات صناعة القرار بما يكفل استقلالا للقرار الوطني ترى فيه واشنطن خطورة شديدة على مصالحا ومصالح “إسرائيل”. ولكي يستقل القرار الوطني فإن ذلك يستلزم نسف السيستم القائم والذي ترعاه الولايات المتحدة الأمريكية وتدعمه وتغض الطرف عن انتهاكاته مهما كانت مروعة ووحشية، كما جرى في رابعة والنهضة وغيرها. إضافة إلى ذلك فإن القوى الخليجية تخشى أساسا من انتقال عدوى الديمقراطية إلى شعوبها، لذلك أبدت عداء صارما للربيع العربي وأنفقت عشرات المليارات من الدولارات من أجل إجهاضه ووأده، وتحالفت مع شياطيين الأرض من أجل إنجاح الثورات المضادة والانقلابات العسكرية.
ثالثا: كشفت التجربة عن أن القوى العلمانية التي تدعي الديمقراطية تضلل الناس فإيمانها بالديمقراطية، كإيمان كبير المنافقين أبي بن سلول بالإسلام، فأساس الديمقراطية هو التسليم بنتائج الانتخابات النزيهة وعدم الانقلاب عليها، لكن هذه القوى ترفع شعار الديمقراطية كسبوبة واسترزاق، فإذا جاءت بهم فبها ونعمت، أما إذا جاءت بخصومهم من الإسلاميين فهم أول الكافرين بنتائجها والمحرضين على المسار الديمقراطي، كما جرى في 30 يونيو 2013م كتمهيد لانقلاب 03 يوليو. وعلى هذه القوى إذا أرادت أن يكون لها دور في مستقبل البلاد إذا حدثت انفتاحة جديدة أن تكف عن خطاب التعالي والإقصاء، وأن تؤمن بالتعايش المشترك واحترام إرادة الشعب لا الانقلاب عليها.
رابعا: تتشكل أضلاع المثلث في مصر من 3 قوى: الجيش من جهة، والإسلاميين من جهة ثانية، والقوى العلمانية كضلع ثالث؛ وأساس المشكلة أن هذه القوى لا تثق في بعضها، فالجيش يريد الوصاية على البلاد لحماية مصالحه وامتيازاته وتلبية كفلائه بالخارج في واشنطن وتل ابيب وأبو ظبي والرياض. والقوى المدنية من الإسلاميين والعلمانيين لم يصلا بعد إلى صيغة للتعايش المشترك، فبينما يتحصن الإسلاميون بشعبيتهم الضخمة وتنظيمهم الحديدي، فإن ضعف القوى العلمانية يدفعها نحو التحصن بالجيش وفق معادلة “استبداد الجيش ولا ديمقراطية الإسلاميين”، وهو ما يستلزم تأسيس خطاب سياسي مشترك يضمن مبادئ التعايش السلمي للجميع دون إقصاء واحترام إرادة الشعب؛ لأن التجربة كشفت عن أن حماية الديمقراطية هي أقرب طريق للاستقرار والتداول السلمي للسلطة، بينما التحصن بالعسكر ينسف الأحلام بالثورة والحرية والكرامة الإنسانية، فهو تبديد للحاصر وتلغيم للمستقبل.
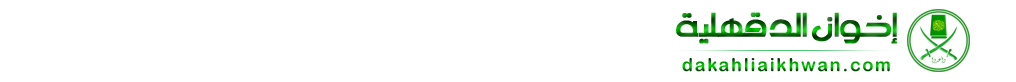 إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية



