
الحمد لله رب العالمين، الواحدُ بلا شريك، القهّار بلا منازع، القوي بلا نصير، العزيز بلا ظهير، أنعم علينا بالإسلام، وجعلنا من أمّة خير الأنام، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحانه سبحانه؛ هو عزّ كل ذليل، وقوّة كل ضعيف، وغوث كل ملهوف، وناصر كل مظلوم، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد رحمة الله للعالمين، أسلمُ الناس صدرًا، وأزكاهُم نفسًا، وأحسنهم خُلُقًا، قال عنه ربنا في كتابه المجيد: {وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ}، أمّا بعـــدُ:
فموعدنا الليلة مع الشرف والمكانة والقيمة العظمى في حياة المسلم، موعدنا مع أشرف انتساب، وأرقى مقام، وأطهر انتماء..
إِنّ من أعظم وأجلّ نعم الله تعالى علينا، نعمة الإسلام، فهي أعلى وأغلى النعم وأنقاها وأرقاها، إنها نعمة الانتساب والانتماء إلى هذا الدين العظيم، يقول الحق -جلّ وعلا- في كتابه المجيد: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} [المائدة: 3]. فلقد اصطفانا الله تعالى من بين خلقه بالانتساب إلى أشرف وأرقى وأنقى الأفكار والشرائع (الإسلام) فحين يتيه اليهود في مادية طاغية، والنصارى في روحانية زائفة، يستقر المقام بالمسلمين عند شاطئ الأمن والأمان والرشاد.. فما أعظم نعمة الله على الإنسان حين يخرجه من الظلمات إلى النور ويهديه للدين الذي ارتضاه له، ليحقق المقصد والوظيفة التي خلق من أجلها وهي عبادة الله، فينال سعادة الدنيا وحسن ثواب الآخرة.
إنه الميراث الحقيقي الذي ورّثه كلّ نبي لأتباعه «الإسلام»، فمنهم من التزم وتمسّك به، ومنهم من شرد وفسد وأفسد، ومن هنا كان من الضروري أن نقف مع هذه الآية الكريمة وقفة تأمّل وتدبّر وعمل.. ففيها بيان عظيم نعمة الله على المسلمين، وبيان كمال الدين وعظمته، وإظهار الفضل من الله على عباده، مما يُلْزمهم بحسن العمل، والقيام بحقّ النعمة المُسْدَاة إليهم..
أولا: لماذا الإسلام نعمة وشرف؟
إنه مما لا شكّ فيه أنّ النسبة إلى الإسلام شرف لا يدانيه شرف، ودرجة لا يقاربها درجة، ونعمةٌ تستوجب الشكر؛ ولم لا؟
والإسلامُ هو الدين الذي ارتضاه الله تعالى لنا دينا، فلماذا لا نرضَى بما رضيه الله لنا، يقول تعالى: {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ} [آل عمران: 19] ولا يُقبل عمل من عبد إلا بالإسلام، فيقول عزّ مِن قائلٍ: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [آل عمران: 85]، فهو الدين الذي ارتضاه الله لنا دينًا، كما في قوله تعالى: {اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلَامَ دِينًا}، وقد ورد عند الترمذي في سننه فيما صححه الشيخ الألباني: عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، قَالَ: قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلَامَ دِينًا} [المائدة: 3] وَعِنْدَهُ يَهُودِيٌّ فَقَالَ: لَوْ أُنْزِلَتْ هَذِهِ عَلَيْنَا لَاتَّخَذْنَا يَوْمَهَا عِيدًا، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «فَإِنَّهَا نَزَلَتْ فِي يَوْمِ عِيدَيْنِ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ، وَيَوْمِ عَرَفَةَ»: قال أبو عيسى الترمذي: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ».. قال ابن كثير في تفسيره لآية المائدة -المشار إليها سابقًا-: «هذه أكبر نعم الله عز وجل على هذه الأمة حيث أكمل تعالى لهم دينهم، فلا يحتاجون إلى دين غيره، ولا إلى نبي غير نبيهم، صلوات الله وسلامه عليه؛ ولهذا جعله الله خاتم الأنبياء، وبعثه إلى الإنس والجن، فلا حلال إلا ما أحله، ولا حرام إلا ما حرمه، ولا دين إلا ما شرعه، وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا خُلْف، كما قال تعالى: وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلا {الأنعام: 115} أي: صدقا في الأخبار، وعدلا في الأوامر والنواهي، فلما أكمل الدين لهم تمت النعمة عليهم ؛ ولهذا قال تعالى:الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلامَ دِينًا {المائدة: 3} أي: فارضوه أنتم لأنفسكم، فإنه الدين الذي رضيه الله وأحبه وبعث به أفضل رسله الكرام، وأنزل به أشرف كتبه». انتهى.
كما أنّ الإسلام هو دين الفطرة؛ حيث يتواءم ويتناسب مع الطبيعة الإنسانية، قال تعالى: {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ ألَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ}، وقال عزّ وجلّ: {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ} فهو دين الفطرة، عليه وُلِد كل إنسان -كما ورد في الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم، من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: ((مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ))..
كما أنه دين التوحيد الخالِص؛ يخلُص فيه العبد لربٍّ واحد يأمره وينهاه، ولا يتنازعه شركاء في العبودية، وصدق الله إذ يقول في سورة الإخلاص: {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ * اللهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ}.. وهذا التوحيد هو سبب السعادة والفرحة للعبد؛ حيث يقينه وثقته -في الرزق والأجل والقضاء والقدر- لا يكون إلا في الله، ولا طمأنينة قلبه إلا من خلال عقيدة التوحيد الخالصة..
كما أنه دين الإنسانية الكاملة؛ حيث لا يدفع الاختلاف مع آخر -في فكرة أو وجهة نظر أو حتى في الدين- إلى نسيان الإنسانية وحقوقها، إنسانية تقوم على العدل والمساواة واحترام الإنسان أيًّا كان دينه ومعتقده، فأما العدل فيه ففي قوله تعالى:«إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ» أوثق بيان، وأما المساواة فلا أدل على ذلك من قصة سرقة المرأة المخزومية -التي حكاها البخاري ومسلم- وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلّم لأسامة وغيره يوم أن أراد أسامة أن يشفع لها، فقال: «أَيُّهَا النَّاسُ إنما هْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ إنهم كَانُوا إذا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ، تَرَكُوهُ وإذا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ، أقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَأيْمُ اللهِ، لَوْ أن فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا»، وأمّا احترام الإنسان أيًّا كان، ففي الحديث الصحيح عند البخاري، أنّ النبي قام لجنازة يهودي، ثم قال: ((أليست نفسًا))، فهو دين المحبة والحب للناس.
كما أن الإسلام هو دين الأخلاق؛ فبعثة النبي الحبيب مختصرة في قوله المشتهر -كما عند البخاري في الأدب المفرد، وأحمد في المسند، ومالك في الموطأ، والحاكم في المستدرك-: ((إنما بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق)) وفي رواية ((حُسن الأخلاق، وصالح الأخلاق))، وهذا يعني أن الانتساب إلى الخُلُق شرف عظيم، وديننا يعلمنا الأخلاق، بل ويجعل الرُّتبة العليا في الدنيا والآخرة لأصحاب الخُلُق الحسَن، وأفضل الناس إيمانًا أحسن الناس أخلاقا؛ فالإيمان رفيقه الخُلُق، حتى رتبة المرافقة للنبي الحبيب في أعلى الجنة لأحسن الناس أخلاقًا؛ كما في الحديث -عند أحمد والترمذي والبخاري في الأدب المفرد- أن النبي سأل الصحابة يومًا: “ألا أُخبركم بأحَبّكم إليَّ وأقْرَبكُمْ منِّي مجلساً يومَ القيامة؟ “، فسَكَت القوم، فأعادها مرتين أو ثلاَثاً، قَال القوم: نعم يا رسول الله، قال: “أحْسَنُكم خُلُقاً”…
كما أنّ الإسلام رفع قدر الإنسانية بظهوره والانتساب إليه، فمن عمر؟ ومن خالد؟ ومن عمرو بن العاص؟ قبل الإسلام؟ لا شيء؛ لا سيما وقد كان البشر جميعًا قبل الإسلام أحطَّ من الوحوش في الغابة، يأكل القويُّ الضعيف، ويتعالى المغرور على الحقير من نظره، فلمَّا بعث الله نبيَّنا محمدًا -صلى الله عليه وسلم- بالإسلام، أنقذ الله به مَن أراد هدايته، فعاش المسلمون في سعادة متآلفين متعاونين، لا فضل لعربي على عجمي، ولا لأبيضَ على أسودَ، إلا بالتقوى، متحابِّين كما قال نبيُّنا – صلوات الله وسلامه عليه-: ((لا يؤمن أحدكم؛ حتى يحبَّ لأخيه ما يحب لنفسه)). فالانتساب إلى الإسلام إذًا شرف ونعمة، تستوجب الشكر والعرفان لمَن أعطاها إيّاك ومنحك إيّاها..
ثانيًا: صور من كمال الدين وعظمته:
وكما سبقت الإشارة إلى كون الإسلام دين الله الأكرم، وشرف المسلم الأعظم، فإن لكمال هذا الدين -الوارد في آية المائدة- صورًا ومظاهر عديدة، نخصّ منها في حديثنا إليكم ما يأتي:
1. كمالُه في توازنه؛ حيث يجمع الإسلام -ضمن تعاليمه وتشريعاته- بين الوحي والعقل، بين العقل والعاطفة، بين الروح والجسد، بين المادية والروحانية؛ وتلك سمة يتفرّد به الإسلام عن غيره من التعاليم والشرائع والأفكار السابقة واللاحقة؛ فاليهود اعتمدوا المادية شعارًا، والنصارى ابتدعوا الرهبانية وما تعاملوا بها، وكان الإسلام -ولا يزال- هو الدّين الجامع بين المادية والروحيّة، ويجمع بين العقل والوحي؛ فلا يرشد العقل إلا بتعاليم الوحي، كما لا يصلح حال الجسد إلا بصفاء الروح والنفس..
2. في يسره وسهولة تطبيق أحكامه وتشريعاته؛ فالإسلام دين اليسر والتيسير، قال تعالى: «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»، فرفع الحَرَج عند حتى عند ممارسة الفرائض كالصلاة والصيام والحجّ المفروض على العبد عند الاستطاعة.. حتى جعل من لم يستطع أن يصلي قائمًا صلى قاعدًا، وهكذا.. كما أنه دين الوسطية حتى في التوبة إلى الله والعودة إليه بالدعاء واللجوء إليه.
3. في شموليته ووسطيته؛ فأمّا الشمول؛ فيقول المولى تبارك وتعالى: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الأنعام: 162]. فكل شيء في حياتنا يمكن أن يكون عبادة بالنسبة الصالحة لله رب العالمين، لا شريك له، وأما وسطية الدين فتلك سمة الأمة المحمدية وصفتها، يقول تعالى في محكم التنزيل:«وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا»، فهو دين الوسطية؛ وسطية في عقيدته: فهو يقيم حججه وبراهينه على أدلة مقنعة ساطعة يوازن فيها بين النقل والعقل. وسطية في شريعته: فكل من اطلع على عبادات الإسلام ومعاملاته يرى أنه لا يحيد عن الموقف المعتدل ويرفض التطرف الذي يقتضي الميل إلى جانب على حساب آخر. كما أنه وسط في الأخلاق والسلوك: فهو دين يكره التشدد والتطرف في السلوك والتصرفات فلا يحب الجبن والخنوع كما لا يحب التهور والاندفاع , ويكره الشدة والقسوة كما يكره الاستسلام لأعداء الإسلام؛ ففي الحديث: «إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ، وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ»..
4. في جمعه بين الجمال والجلال: يقول ابن تيمية في الجواب الصحيح: «… ففي شريعته -صلَّى الله عليه وسلَّم- من اللين والعفو والصفح ومكارم الأخلاق أعظم مما في الإنجيل، وفيها من الشدَّة والجهاد، وإقامة الحدود على الكفَّار والمنافقين أعظم ممَّا في التوراة، وهذا هو غاية الكمال؛ ولهذا قال بعضهم: بُعث موسى بالجلال، وبُعث عيسى بالجمال، وبُعث محمد بالكمال».
5. في تكريم المرأة ورفع شأنها في عصر الانحلال: إنّه دين الكمال في إعادة كرامة المرأة إليها من جديد، بعد عصر الامتهان في الجاهلية، والامتهان في العصر الحديث؛ حيث كرمها أما وبنتا وأختا وعمة وخالة وزوجة؛ إنها مربية الأجيال، وصانعة الرجال، ومنتجة الأبطال، ألا ليست قومي يعلمون!!
6. في احترام حقوق الإنسان ولو كان كافرًا؛ ولا أدلّ على ذلك من موقف النبي حين قام لجنازة اليهودي، وعوتب من بعض أصحابه، فقال لهم: (أليست نفسًا). كما أنّ من كماله العمل على حفظ النفس البشرية بعقيدته وتشريعاته وأخلاقه، وحرّم الاعتداء عليها بأي وسيلة كانت، واعتبر قتل نفس واحدة كمن قتل البشرية كلها، -فليس الإسلام دينًا يقتل أو يروّع الآمنين-، كما عمل الإسلامُ على تحريم كل ما فيه ضرر على الإنسان والإنسانية.
7. في احترام المشاعر وتقدير العواطف، وتطييب الخواطِـر، ولتنظر أخي المسلم إلى موقف الرسول يوم حُنيْن حين غضب بعض الأنصار لعطاء النبي للمهاجرين والمؤلفة قلوبهم ولم يعطهم، فوقف بينهم وسكب عبراته، وأعلن لهم -بصراحة وحب- أن الحياة معهم، والموت معهم، وطيّب خواطرهم بقوله: (أترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون أنتم برسول الله).
8. في احترامه لحقوق الحيوان وعدم جعله مقصدًا لرميّ أو تسلية بقتل؛ فلقد حافَظ الإسلام على حياة الحيوان والطير، فقصة المرأة التي حبَسَت الهرةَ، والبغيِّ التي سقَت الكلبَ، والنهي عن اتخاذ الطير هدفًا يُرمى – كلها قصص مشهورة تفيد أن الإسلام حافَظَ على حياة الحيوان، فكيف بابن آدم الذي كرَّمه الله؟! ومما يؤكّد حق الحيوان في الحياة والمعاملة الطيبة، حديث: «مَا مِنْ إِنْسَانٍ قَتَلَ عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا، إِلَّا سَأَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهَا”، قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: “يَذْبَحُهَا فَيَأْكُلُهَا، وَلَا يَقْطَعُ رَأْسَهَا يَرْمِي بِهَا» بل ومن كمال الإسلام وعظمته أنه يأمر أتباعه بالإحسان حتى عند قتل الذبائح -المباح ذبحها وأكلها- فكما عند مسلم: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ ولْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ» أرأيتم دينًا بهذا الكمال وتلك العظمة؟!!.
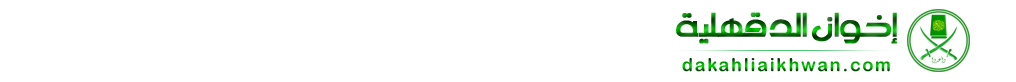 إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية



