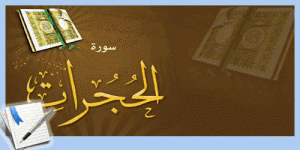
(يَا أيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُولِه وَاتَّقُوا اللهَ إنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ . يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أنْ تَحْبَطَ أعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ . إنَّ الذِينَ يَغُضُّونَ أصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ) (سورة الحجرات: 1،2،3)
هذه الآيات أدَّب الله تعالى بها عباده المؤمنين فيما يُعاملون به الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ من التوقير والاحترام، والتبجيل والإعظام، فقال ـ تبارك وتعالى ـ: (يَا أيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُولِه)، أي لا تُسرعوا في الأشياء بين يديه أي ـ قبله ـ بل كانوا تبعًا له في جميع الأمور حتى يدخل في عموم هذا الأدب الشرعي حديث معاذ ـ رضي الله عنه ـ حيث قال له النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ حين بعثه إلى اليمن: بِمَ تحكم؟ قال: بكتاب الله تعالى: قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله فقال ـ صلى الله عليه وسلم ـ: فإن لم تجد؟ قال ـ رضي الله عنه ـ: أجتهد برأي، فضرب في صدره وقال: الحمد لله الذي وفَّق رسولَ رسولِ الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لما يُرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقد رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة. فالغرض منه أنَّه أخَّر رأيه ونظَرَه واجتهَادَه إلى ما بعد الكتاب والسنة، ولو قدَّمه قبل البحث عنهما لكان من باب التقديم بين يدي الله ورسوله.
قال عليٌّ بن أبي طلحة عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: (لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي اللهِ وَرَسُولِهِ) لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة.
وقال الضحاك: لا تُفْضوا أمرًا دون الله ورسوله من شرائع دينكم، وقال سفيان الثوري: ولا تقدموا بين يدي الله ورسوله بقول ولا فعل، قوله تعالى: (يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ).
هذا أدبٌ ثانٍ أدّب الله تعالى به المؤمنين ألا يرفعوا أصواتهم بين يدي النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فوق صوته..
وقال البخاري: حدَّثنا على بن عبد الله، حدثنا أزهر بن سعد، أخبرنا ابن عون، أنبأني موسى بن أنس عن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ افتقد ثابتَ بنَ قيس ـ رضي الله عنه ـ فقال رجل: يا رسول الله، أنا أعلم لك عِلْمَه، فأتاه فوجده في بيته مُنكِّسًا رأسه، فقال له: ما شأنك؟ فقال: شرٌّ، كان يرفع صوته فوق صوت النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقد حبط عمله، فهو من أهل النار فأتى الرجلُ النبيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فأخبره أنه قال كذا وكذا ” قال موسى: فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة فقال: اذهب إليه فقل له: إنك لستَ من أهل النار، ولكنك من أهل الجنة.
وقال الإمام أحمد: حدَّثنا سليمان ابن المغيرة عن ثابت، عن أنس بن مالك ـ رضي الله
عنه ـ قال: لما نزلت هذه الآية: (يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ) إلى قوله (وَأنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ). وكان ثابت بن قيس بن الشمَّاس رفيع الصوت فقال: أنا الذي كنت أرفع صوتي على رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنا من أهل النار، حَبِطَ عَمَلي، وجلس في أهله حزينًا، ففقده رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فانطلق بعض القوم إليه فقالوا له: تفقَّدك رسولُ الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ما لك؟ قال: أنا الذي أرفع صوتي فوق صوت النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأجهر له بالقول، حبط عملي، أنا من أهل النار، فأتَوُا
النبيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فأخبروه بما قال، فقال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: لا، بل هو من أهل الجنة، قال أنس ـ رضي الله عنه ـ: فكنا نراه يمشي بين أظْهُرِنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة، فلما كان يوم اليمامة كان فينا بعضُ الانكشاف، فجاء ثابت بن قيس بن الشماس وقد تحنَّط، ولَبِسَ كفنه، فقال: بئسما تُعوِّدون أقرانكم، فقاتلهم حتى قُتل ـ رضي الله عنه.
وقد رُوِّينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ أنه سمع صوتَ رجلين في مسجد النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قد ارتفعت أصواتهما، فجاء فقال: أتدريان أين أنتما؟ ثم قال: من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف.. فقال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربًا. وقال العلماء: يُكْرَه رفْعُ الصوت عند قبره ـ صلى الله عليه وسلم ـ كما كان يُكره في حياته ـ عليه الصلاة والسلام ـ لأنه محترَم حيًّا وفي قبره ـ صلى الله عليه وسلم ـ دائمًا..
في قول الله تعالى: (يَا أيُّها النَّاسُ إنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعْلَنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إنَّ أكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أتْقَاكُمْ إنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) (سورة الحجرات:13)
إن الله ـ سبحانه ـ في حكمته السامية ما جعل الناس شعوبًا وقبائل ليتدابروا ويتنافروا، فإن الإسلام قد نهى عن التدابر والتنافر، وأمر بالتعاطف والتراحم حيث قال ـ صلى الله
عليه وسلم ـ: لا تَقاطعوا ولا تَدابروا ولا تَباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانًا، ولا يَحِلُّ لمسلم أن يَهْجُرَ أخاه فوق ثلاث، وأمرهم أن يعملوا جاهدين لتحقيق الخير من أجل الإنسانية حتى يُثيبهم عليه تزكية نفس وصفاء روحٍ وأمْنًا وطمأنينة والتجاءً إلى الله شكرًا وعرفانًا فتكون التقوى، فيصل الإنسان إلى أن يكون كريمًا عند الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فإذا ما كان الفرد كريمًا على الله فإن الله لا يُسلمه ولا يَخذله، ومَنْ يثِقْ بالله يجعل له مخرجًا ويرزقْه من حيث لا يحتسب ومن يتوكلْ على الله فهو حسبه، وإذا كان المجتمع كريمًا على الله بالتقوى فإن الله ـ سبحانه ـ يكون عونه وناصره وكفى بربك هاديًا ونصيرًا للفرد، وهاديًا ونصيرًا للمجتمع، ويتحقق الإسلام للفرد وللإنسانية تحققًا كاملًا باتباعهم الرحمة والأخوة والتعارف، أو بتعبير أقصر بإسلامهم؛ لأن الإسلام إنما هو أن يُسلم الإنسان وجهه لله، يسلمه له إسلامًا كاملًا لا شائبة فيه من تعصب بيئي أو عنصري، قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ فيما رواه أبو داود: “ليس منَّا مَنْ دعا إلى عصبية، وليس منَّا مَنْ قاتل عصبية، وليس منَّا مَنْ مات على عصبية” والإسلام ليس فيه تعصب ولا افتخار بالآباء والأجداد، يقول ـ صلى الله عليه وسلم ـ في حِجَّة الوداع “إن الله أذهب عنكم عيبة الجاهلية وتعظمها بالآباء والأجداد، الناس لآدمَ، وآدمُ من تراب، ولا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى“، وقال ـ صلى الله عليه وسلم ـ لرجل قال لصاحبه يا ابن السوداء: “إنك امرؤ فيك جاهلية”. ويجب أن يكون إسلامًا صافيًا كاملًا حتى تكون صلاته ونسكه ومحياه ومماته لله رب العالمين لا شريك له، فإذا ما أسلم وجهه هذا الإسلام كان رحمة وكان تعاطفًا، وكانت صلته بالشعوب والقبائل صلة تعارف لا صلة تنافر ولا تعادي ولا تدابر، وصلة الإسلام إذن بالسلام الفردي والسلام العالمي على هذا الوضع صلة واضحة.
إن الإسلام هو الموصل للسلام العالمي، يقول الله تعالى: (قَدْ جَاءكُمْ مِنَ اللهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إلَى النُّورِ بِإذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) فكتاب الله ـ سبحانه ـ هو الذي يرسُم السلام ويرسم سبل السلام، وهو ـ سبحانه ـ إذا فعل ذلك فإنما يفعله على علم ويفعله على حكمة، والله ـ سبحانه ـ يأمر المؤمنين جميعًا أن يدخلوا في الإسلام كافَّةً (يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ) وعدم الدخول في السلم إنما هو اتباع خطوات الشيطان.
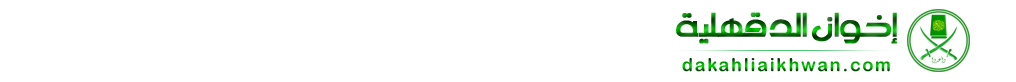 إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية



