
بقلم: عامر شماخ
الشرعية اسم مؤنث منسوب إلى شرْع، كون الشىء قائمًا على أساس شرعىّ، ومنها الشرعية القانونية، والدولية، واللفظ فى الاصطلاح السياسى المصرى الحالى تعنى ذلك التيار السياسى العريض الذى حاز ثقة الشعب فى عدة استحقاقات انتخابية ومنها رئاسة الجمهورية، حتى جرت عملية سطو مسلح على هذا التيار من جانب العسكر، وبمعاونة التيارات العلمانية المعادية للدين، فتم عزل هذا التيار عن الحكم، بل نُكل بالمنتمين إليه، وهم من يُعرفون بأهل الشرعية..
وفى هذه الأيام هناك مساجلات بين أهل الشرعية أنفسهم؛ إذ ظهر من بينهم نفر ينادون بالتخلى عن حقوقهم التى منحها لهم الشعب، وبعدم الوقوف فى وجه من سرق هذه الحقوق بالإكراه، ويدعون قيادة التيار إلى التسليم بالواقع، والرضا بالقليل، وطلب العفو والسماح من المغتصبين؛ ظنًا منهم أن ذلك يفك الأسير، ويحرر السجين، ويرد الأموال المصادرة لأصحابها..
وهذا كلام يحتاج إلى وقفة طويلة، لا يتسع المقال لتفاصيلها؛ من ثم سوف نوجز القول، ونذكِّر بما غمض، ونزيل لبسًا حجز الحقائق عن أصحاب هذه الدعوة؛ إذ لا نشك فى نياتهم، بل هم إخوة كرام يسعون إلى حل الأزمة، لكنهم أتوها من ظهرها، كمن أراد خرق السفينة استعجالا لطلب الشرب، ولا يدرون أن ذلك الخرق فيه غرقهم وغرق الجميع..
ونؤكد – بادئ ذى بدء- أنه ما من أحد سلك طريق أهل الشرعية إلا أوذى، ولو سلم أحد لسلم الأنبياء -عليهم صلوات الله- ولو أراد الله أن يتخطف أعداءهم لفعل، لكنها إرادته فى الإملاء للظالم، ولتمييز الخبيث من الطيب، ولا نشك برهة أن هؤلاء الأكارم -أى الأنبياء- لم يدعوا سببًا إلا أخذوا به، وما تركوا واديًا فيه الغلبة إلا سلكوه، ورغم ذلك هُزموا فى مواضع، وابتلوا ومحصوا فى مواضع أخرى، فما عجلوا، وما عاتبوا ربهم على ما فعله بهم؛ ليكونوا لنا قدوات الطريق، ولنعلم أن ما يأتى رخيصًا يذهب سريعًا؛ إذ يصعب الحفاظ عليه، وما تُقدّم له التضحيات ويُبذل لأجله الغالى والرخيص يصعب التفريط فيه والانفكاك عنه..
– فهل تعلم يا أخى أن نوحًا -عليه السلام- بقى فى قومه يدعوهم ألف سنة إلا خمسين عامًا، فلم يدع وسيلة من أجل هدايتهم إلا أخذ بها، وما سلم -رغم ذلك- من أذاهم ومكرهم «ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون» [هود: 38]، فما علمنا أنه قد قصر فى الأخذ بالأسباب، وما اتهمه أحد، عالمًا أو جاهلا، منذ زمنه حتى الآن أنه كان عاجزًا أو فاشلا -لا سمح الله.
– وهل تعلم يا أخى أن أبا الأنبياء إبراهيم -عليه السلام- ألقى فى النار، فما صرفه ذلك عن دينه شيئًا، وأن الجميع تكالبوا عليه حتى الوزغ -الأبراص- فما زادته ذلك إلا ثقة فى ربه ويقينًا فى عدله ورحمته وعزته وقوته، فقال لرسوله: «علمه بحالى يغنى عن سؤالى»، فكان الرد: «يا نار كونى بردًا وسلامًا على إبراهيم» [الأنبياء: 69]، وفى السورة المسماة باسمه: «وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون» [إبراهيم: 12]، وفيها: «وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام» [إبراهيم: 46، 47].
– وهل تعلم أن كليم الله موسى -عليه السلام- واجه أعتى الفراعنة؛ من قال «أنا ربكم الأعلى» [النازعات: 79]، «ما علمت لكم من إله غيرى» [القصص: 28]، «أليس لى ملك مصر وهذه الأنهار تجرى من تحتى» [الزخرف: 51]، وقد علا فى الأرض، وجعل أهلها شيعًا، يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحى نساءهم، إفسادًا فى الأرض ومحاداة لله.. ولم نسمع أن موسى قصّر فى عمل، أو أنه استثقل المهمة، بل صبر وثبت، واستعان بأخيه الأفصح لسانًا، وانتظر وعد الله الذى جاءه مدويًا تحكيه آيات القرآن التى نعجز عن حصرها فى هذا المقال، يوجزها قول الله فى مطلع سورة القصص: «ونريد أن نمن على الذين استضعفوا فى الأرض، ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم فى الأرض، ونرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون» [القصص: 5، 6].
– وهل تعلم أن ما فُعل بيوسف عليه السلام لم يسقط حقه الذى هضمه إخوته، بل ضوعف له الجزاء أضعافًا؛ لأنه صبر وغفر، فالحق أحق أن يتبع، وما كان لله دام واتصل، وما كان لغيره انقطع وانفصل، ولم يشفع لإخوته أنهم أبناء نبى، بل ظهر الحق وبطل الباطل، والسر فى قول الله -تعالى- كما جاء على لسان الكريم ابن الكريم ابن الكريم: «إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين» [يوسف: 90]، وبعد الجب والبيع والحبس يصير عزيزًا لمصر، وزيرًا لها ويأتيه إخوته نادمين منكسرين، «قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين» [يوسف: 91، 92]، وتأتيه المرأة معتذرة باكية قالت: «الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدى كيد الخائنين» [يوسف: 51، 52].
وفى السورة نفسها سرٌ عظيم؛ إذ تلخص -فى نهايتها- سمات طريق أهل الشرعية الذى لا بديل له سوى الزيع والضلال، يقول الله: «قل هذه سبيلى، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى، وسبحان الله وما أنا من المشركين» [يوسف: 108].
ولعلك تكون أدرى منى بما فُعل بحبيبك محمد -صلى الله عليه وسلم- منذ يوم بعثته إلى يوم انتقاله إلى الرفيق الأعلى، فما استراح يومًا فى دنيا الناس، وما شبع من طعام قط، وقد ظلمه الأقربون وعادوه، وداسوا على الأعراف والقيم لأجل إعناته، فما أخرجه كل ذلك عن صبره وحلمه وعفوه وكريم خلقه.
وتتفق معى أنه النبى الأبرز فى الأخذ بالأسباب وتحرى الواقع، لكنه لم يسلم من الوقوع فى الهزائم والنكسات؛ لتتعلم أمته من بعده: أن الأسباب وحدها لا تغنى، وأن التوكل على ربها -بعد الأخذ بها- ضامن للنصر والتوفيق [راجع آيات آل عمران: 120- 185 حول غزوة أحد، وراجع تفاصيل غزوة حنين فى مصادرها، وراجع ما حدث للقراء الذين قتلوا على يد المشركين].
فى الحقيقة أن الناس عندما يقدمون عواطفهم للحكم على الأمور دون عقولهم يقعون فى الخطأ، وينخدعون بأشياء ما كان لهم أن ينخدعوا بها لو ألجموا نزوات عواطفهم تلك بنظرات عقولهم، وهذا لا يطعن فى نياتهم وقصدهم، ولو طعن أحد فيهم لكان عمر -رضى الله عنه- أول المطعونين [راجع موقفه يوم الحديبية ويوم موت النبى، ويوم غدر عبد الله بن أبى فى ماء المريسيع، وفى حروب الردة، وفى السقيفة، وغيرها].
ولذلك فإن كثيرًا من الصالحين الذين زاغوا أو انحرفوا، ما وقع لهم ذلك وسقطوا على طريق الدعوة إلا لغلبة عواطفهم، ولاستعجالهم، ولافتتناهم بقوة خصمهم، على غير نظرة من يحكمون العقل فى النظر إلى الأشياء، كالأفاضل الذين قالوا يوم الأحزاب «هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانًا وتسليمًا، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا….» [الأحزاب: 22، 23].
وإذا كان خباب قد بدا يائسًا، فقد ظهر عبد الله بن مسعود مندفعًا متحمسًا، رغم تفاوت القوة الجسدية والخلفية القبلية بين الاثنين، وظهر خبيب بن عدى ثابتًا صامدًا عزيزًا جسورًا، لم يبال على أى جنب كان فى الله مصرعه، ولما خُيِّر أن يكون فى أهله معافى ومحمد مكانه، قال ما أود أن يشاك بشوكة، حتى قال زعيم المشركين: ما رأيت أحدًا يحب أحدًا كما يحب أصحاب محمد محمدًا، وظهر عدى بن حاتم الطائى واثقًا فيما تنبأ به النبى رغم بُعد النبوءات عن الواقع -عندما قيلت- بُعد السماء عن الأرض.. إنها الثقة فى وعد الله، والإخلاص لدينه، والتدبر الحقيقى والمتجرد لكتاب الله وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم-.
هناك فرق كبير من بين يرفعون شعار: «لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده» [البقرة: 249]، ومن يرفعون شعار: «فاقض ما أنت قاض إنما تقضى هذه الحياة الدنيا…» [طه: 72]، فالأولون لا يودون بذل الجهد، ولا يصبرون، ولا يستعينون بالله لرفع البلاء، معتمدين على قليل من الأسباب، أما الآخرون فيبذلون ما يطيقون، «لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها» [البقرة: 286]، «لا يكلف الله نفسًا إلا ما آتاها» [الطلاق: 7]، ولا يحل مشكلة وأزمة الطائفة الأولى إلا فرد أو جماعة يذكرونهم بالله وقدرته، وتفاهة الخصم وصغار كيده؛ حتى تنشرح صدورهم، وتتيسر أمورهم، ويقبلون على المعركة صامدين، غير هيابين أو مترددين.
وإذا كان التاريخ يكرر نفسه -كما يقولون- فإن التاريخ القريب لجماعة الإخوان المسلمين يذكرنا بفضل الثبات والصمود، وألا تهزنا رياح الخصم وأعاصيره، وهناك علم من أعلام الدعوة صدر الحكم بإعدامه، وتحركت الدنيا لمنع ذلك، وخاطبه الزعماء والرؤساء للنطق بكلمة تأييد واحدة للهالك عبد الناصر، فما طاوعته نفسه لذلك، وقد كان مريضًا مرضًا مقعدًا يعطيه المبرر والعذر بل قال: «إن السبابة التى تشهد لله بالوحدانية لا يحق لها تأييد ظالم»، إنه الشهيد سيد قطب الذى يبعث برسالة أخرى إلى الإخوة المتعجلين، بألا يقصروا نظرتهم للأمور على واقعهم الضيق، إنما يجب أن يمتد النظر إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير، يقول رحمه الله: «ستظل كلماتنا عرائس من الشمع، لا روح فيها ولا حياة، حتى إذا متنا فى سبيلها دبت فيها الروح وكتبت لها الحياة».
اليوم ظلم وتضييق وإيذاء، وغدًا فرح وسرور واستبشار، وما ضاع حق وراءه مطالب، من غير وجل ولا تردد ولا وهن، فقد وقع اللوم على أصحاب موسى الذين قالوا له: «إنا لن ندخلها أبدًَا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا، إنا هاهنا قاعدون» [المائدة: 24]، وسجل التاريخ بكلمات من نور قول أصحاب محمد له: «امض يا رسول الله إلى ما أمرك الله، لا نقول لك ما قال أصحاب موسى لموسى، بل إنا معك مقاتلون، والله لو خضت هذا البحر لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد، فامض يا رسول الله».
وإن لله تعالى حكمة فى تأخير النصر للمؤمنين، رغم بأسهم، مع أن النصر آت لا محالة كما قال سبحانه: «حتى إذا استيئس الرسل وظنوا أنهم قد كُذبوا جاءهم نصرنا، فنجى من نشاء، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين» [يوسف: 110]؛ وذلك إما لأن بنية الأمة- كما قال الشهيد سيد قطب- لم تنضج بعدُ ولم يتم بعدُ تمامها، ولم تحشد بعد طاقاتها… فلو نالت النصر حينئذ لفقدته وشيكًا؛ لعدم قدرتها على حمايته طويلاً، ويتأخر النصر كى يلجأ الناس إلى الله، ولتتمايز الصفوف: «أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة، والله خبير بما تعملون» [التوبة: 16]، «وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين» [آل عمران: 140]، ويتأخر النصر أيضًا ليرفع الله -كما قال العلماء- الظلم العظيم بالبلاء العظيم.
إن الواثق فى ربه، الشاخص ببصره ناحية السماء، لا يقلق ولا يحزن، ولا يخاف، ولا ييأس، ولا يجزع، ولا يهلع، ولا يقنط من رحمة ربه، فالله -جلت قدرته- فرّق الأحزاب بالريح، وقذف الرعب فى قلب يهود بني النضير، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين، فاعتبروا يا أولى الأبصار، وقلل الطائفتين وكثرهما فى بدر كى يكون قتال ينتصر فيه المسلمون، إلخ..
ولا أجد فى النهاية مثل قول الصحابى الجليل أنس بن النضر الخزرجي، وكان يشرف على الموت يوم أحد «قالوا له: قُتل رسول الله -صلى الله عليه وسلم، قال: وماذا تصنعون من بعده، قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-».
فالصبر الصبر، والثبات الثبات والله معكم ولن يتركم أعمالكم، «فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون» [الروم: 60].
————————————————————————
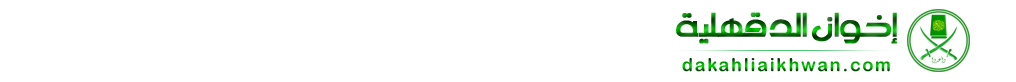 إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية



